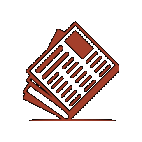

في اليوم الـ23 من استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحي الشجاعية، اُستشهد فيها نحو 35، وأصيب 50 معظمهم نساء وأطفال. وذكرت وزارة الصحة، أن الاحتلال قصف الحي بصواريخ ضخمة. وبلغ عدد الشهداء في القطاع 45 شهيدا منذ فجر اليوم.

في اليوم الـ24 من استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصل الاحتلال قصف عدة مناطق في القطاع، عقب تهديد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بتصعيد العمليات إذا لم تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن جميع المحتجزين الإسرائيليين قريبا.

ويمهد الانسحاب -الذي يأتي ضمن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في العاشر من مارس/آذار الماضي- لإعادة دمج الحيين في هيكلية الحكومة السورية.

قال موقع "دروب سايت نيوز" إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفعت دعوى قانونية غير مسبوقة تطالب حكومة بريطانيا بشطبها من لائحة "المنظمات الإرهابية" والاعتراف بدورها باعتبارها حركة مقاومة فلسطينية منخرطة في النضال من أجل تقرير المصير والتحرر.وأضاف الموقع أن الحركة استعانت بمحامين بريطانيين لينوبوا عنها في هذه الدعوى التي تستهدف إلغاء تصنيفها منظمة إرهابية في بريطانيا، والذي دخل حيز التنفيذ في العام 2021.وكان التصنيف يقتصر على كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، ولكن الحكومة البريطانية اعتبرت حينها أن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة "مصطنع".وقال المحامون إنه يتوجب على الحكومة البريطانية قانونيا التدخل لمنع الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وأن تعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرين إلى أن التصنيف الذي يستهدف حماس مخالف لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي.وأوضحوا أن حماس هي القوة المسلحة الفلسطينية الوحيدة الفاعلة، وأن تصنيفها منظمة إرهابية يعيق قدرة الفلسطينيين على التصدي لأعمال الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل حاليا ضد الفلسطينيين في غزة.ونشر الموقع وثيقة مرفقة بالدعوى تحمل توقيع عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق ومؤرخة في 26 مارس/آذار الماضي.وفي هذه الوثيقة، أكد أبو مرزوق أن حماس حركة مقاومة إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وليست منظمة إرهابية.كما شدد القيادي في حماس على أن الحركة لا تستهدف المواطنين البريطانيين سواء داخل بريطانيا أو خارجها، كما أنها ليست معادية للسامية، ولا تشكل تهديدا للدول الغربية.وقال عضو المكتب السياسي لحماس إن الحركة لم تنفذ أي عمليات مسلحة خارج حدود فلسطين التاريخية.ووصف أبو مرزوق قرار حظر حماس وتجريمها بأنه قرار جائر نابع من دعم غير مشروط للصهيونية والاحتلال والاستعمار في فلسطين.

وتوضح الصور الدمار الكبير الذي حل بالمكان ومحاولات إخراج الضحايا سواء الأحياء أو الشهداء من تحت الأنقاض.

كشفت صحيفة إسرائيلية عن أن قادة هددوا عسكريين بجيش الاحتلال بالفصل من الخدمة إذا لم يسحبوا توقيعاتهم على رسالة تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة.ومساء اليوم، قالت صحيفة هآرتس إن "970 من أفراد طاقم الطائرات بسلاح الجو الإسرائيلي وقعوا على رسالة تعارض الحرب، ولكنها لا تدعو إلى رفض الخدمة".وأضافت أنه "في الأيام الأخيرة، أجرى كبار القادة في سلاح الجو مكالمات هاتفية شخصية مع أفراد خدمة الاحتياط في السلاح، الذين وقعوا على الرسالة الجديدة ضد استمرار القتال في قطاع غزة".وقالت الصحيفة إن "القادة أبلغوا عناصر الاحتياط بسلاح الجو بأنهم إذا لم يسحبوا توقيعاتهم، فسوف يتم فصلهم من الخدمة".وبعد التهديد، سحب 25 فقط من الموقعين على الرسالة توقيعاتهم، وطلب 8 جدد إضافة توقيعاتهم بسبب التهديد بالفصل الفوري من الخدمة، وفق المصدر ذاته.وأكد الموقعون على الرسالة، بما في ذلك كبار ضباط سلاح الجو الإسرائيلي والطيارون، أن "القتال في غزة يخدم مصالح سياسية، وليس أمنية".

في يناير/كانون الثاني الماضي 2025 وفي جلسة استماع له في مجلس الشيوخ الأميركي، قال بيت هيغسيث مدافعا عن اختيار دونالد ترامب له: "صحيح أنني لا أملك سيرة ذاتية مشابهة لسير وزراء الدفاع خلال العقود الثلاثة الماضية، لقد وضعنا مرارا وتكرارا أشخاصا على رأس البنتاغون بالمؤهلات الصحيحة المفترضة.. إلى أين أوصلنا هذا؟".ورغم هذه الروح الساخرة التي أبداها للسائلين له، بل والسخرية من المسار التقليدي لتعيين وزراء الدفاع في تاريخ الولايات المتحدة، واعتراض أعضاء مجلس الشيوخ، فقد ثُبّت تعيين وزير الدفاع بيت هيغسيث أخيرا وسط جدل كبير حول مؤهلاته وتاريخه المثير.وتحوّل الرجل من جندي في الجيش الأميركي في حروب العراق وأفغانستان إلى معلق سياسي بارز في قناة "فوكس نيوز" ومن ثم المذيع المفضل لترامب كما كان يوصف، ثم أخيرا إلى منصب وزير الدفاع الأميركي.واللافت أن هيغسيث لم يكن مجرد صوت عابر في الساحة السياسية الأميركية أو مذيع موتور، إذ اتَّسمت تصريحاته بالجرأة والتطرف، الأمر الذي جعله رمزا لتيارٍ محافظ متشدِّد يرى العالم من خلال عدسة صراع حضاري لا هوادة فيه.فمَن بيت هيغسيث؟ وما أبرز مواقفه وتصريحاته الغريبة تجاه الإسلام والقضية الفلسطينية؟وُلد بيت هيغسيث في عام 1980 في ولاية مينيسوتا الأميركية، ووفقا لتقرير نشرته الجزيرة نت فإنه تلقى تعليمه الثانوي في مدرسة "فورست ليك" في الولاية ذاتها، قبل أن يلتحق بجامعة برينستون حيث حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية عام 2003، ثم واصل بعدها دراسته العليا في كلية "جون إف. كينيدي" التابعة لجامعة هارفارد، ونال منها درجة الماجستير في السياسات العامة عام 2013.بدأت أفكاره السياسية بالبزوغ خلال فترة رئاسة جورج دبليو بوش، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. في تلك الفترة، كان طالبًا جامعيًا، وقد عبّر عن تأييده للتدخل العسكري عبر مقال نشره في صحيفة الجامعة، دافع فيه عن خيار استخدام القوة.ومن ثم كان هيغسيث من أبرز المؤيدين لغزو العراق عام 2003، ليس فقط من منطلق نظري، بل من خلال مشاركته الفعلية كجندي في صفوف الجيش الأميركي خلال تلك الحرب، إلا أن موقفه من هذا الملف تغيّر جذريًا بمرور الوقت، ليصرّح لاحقا بعد قرابة عقدين بأن الولايات المتحدة "ما كان ينبغي لها أبدًا أن تغزو العراق".وفي أثناء خدمته في حروب العراق وأفغانستان حصل على ميداليتين برونزيتين لشجاعته، وعقب تركه الخدمة العسكرية اتجه إلى العمل السياسي والإعلامي، ليصبح وجها مألوفا في قناة "فوكس نيوز" منذ عام 2014.كما ألف كتابًا بعنوان "في الميدان" (In the Arena) في 2016، وفيه عبّر عن آرائه حول القيادة الأميركية والصراعات العالمية.وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فإن ترشيحه لمنصب وزير الدفاع جاء كجزء من رؤية ترامب لتعيين شخصيات متشددة في إدارته الجديدة، مما يعكس ثقة الرئيس الأميركي في مواقف هيغسيث الجريئة، بل وصفت الصحيفة هذا التعيين بمثابة استعراض للقوة.ومن بين هذه المواقف الجريئة التي أعلنها هيغسيث صراحة انتقاده لمفهوم "التنوع هو قوتنا" في الجيش الأميركي، ففي فبراير/شباط 2025، وصف هيغسيث عبارة "التنوع هو قوتنا" بأنها "أغبى عبارة في تاريخ الجيش"، معبرا عن رفضه لسياسات التنوع والشمولية والمساواة في القوات المسلحة.وقد تساءل ذات مرة عن سبب اختيار الجنرال تشارلز كوينتون براون جونيور المعروف بـ"سي كيو براون"، كأول أميركي من أصل أفريقي يقود هيئة الأركان المشتركة في الفترة ما بين 2023 و2025، وقد أُقيل براون من منصبه مع مجيء هيغسيث، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول مواقفه من التنوع في الجيش.لكن ما يلفت النظر في هيغسيث ليس فقط خلفيته العسكرية اليمينية أو دوره الإعلامي، بل لغته الحادة التي لا تعرف المهادنة، وخاصة ما يتعلق بتصريحاته حول الإسلام والمسلمين في قضايا مختلفة.لم يُخفِ بيت هيغسيث يوما رؤيته المتشددة تجاه الإسلام، وهي رؤية يراها البعض امتدادًا لفكر "الحروب الصليبية" الحديثة، فيقول في كتابه "في الميدان": "الإسلام، وخاصة الإسلاموية، قائم على تقاليد دينية مُغلقة ومُتصلبة".تبدو هذه النظرة المتشددة تجاه الإسلام بصورة جلية حين نفتش في كتابه السابق عن المؤثرات الفكرية التي اعتنقها وزير الدفاع الأميركي في هذه الرؤية التي تصف الإسلام والإسلاموية على حد وصفه بالانغلاق والتصلب، فسنجد مع النظرة الصليبية التاريخية التقليدية، تأثرا واضحا بأفكار فرانسيس فوكوياما حول نهاية التاريخ، وضرورة صدام الحضارات وخاصة الإسلام الذي يعد مهددا لعصر ما بعد الحداثة.تظهر أفكار هيغسيث جلية في أثناء انتقاده تقليل عدد القوات الأميركية في العراق بعد 2011، ففي كتابه السابق يرى -وهو الشاهد في الوقت عينه- أن زيادة القوات عام 2007 في العراق وتغيير الإستراتيجية الأميركية كان التطبيق الفعال للقوة الأميركية اللازمة لتحقيق نتيجة جيدة.يقول: "تُثبت دروس هذا الجهد -بالإضافة إلى فائدة الإدراك المتأخر- أن أميركا المنخرطة والعدائية والقوية أكثر فعالية من أميركا الخجولة والمعتذرة التي تقود من الخلف".ويبدي هيغسيث موقفا متعصبا من الحركات الإسلامية كافة، ويحذر من خطرها وضرورة الوقوف أمامها، ففي كتابه "في الميدان" نراه يقول: "الإسلاموية الزاحفة -وهي حركة مكرّسة لفرض هيمنة الإسلام ونشره بوسائل سلمية وعنيفة على حد سواء- تتقدم، في حين تتراجع المساواة الأميركية. متى وأين ستتوقف؟ لن تتوقف إلا إذا نهض المواطنون الصالحون وواجهوها".وهو يدرك أن كثيرا من أطروحاته وتصريحاته تتسم بالعدائية الشديدة والتطرف ويعترف بهذا حين يصفُ النقاد موقفه هذا بالتعصب، ولكن من وصفهم بالمواطنين الصالحين ممن يخوضون غمار الواقع يدركون أن الأمر لا علاقة له بالتعصب، "بل بكل ما يتعلق بالحفاظ على مبادئ جمهوريتنا الهشة وشريان حياتها. المسألة تتعلق بأميركا فقط".ومع هذه المواقف وفي عام 2020 أصدر بيت هيغسيث كتابه الآخر، والأكثر إثارة للجدل بعنوان "الحملة الصليبية الأميركية" (American Crusade)، وفيه نرى بوضوح لا ريبة فيه أن هيغسيث يصارع بلا هوادة كل من يخالف أفكاره السياسية والدينية التي تنحو منحى التطرف اليميني الجلي، ويرى أن معظم هذه التيارات الفكرية يسارية كانت أم إسلامية أشد خطرا على واقع ومستقبل الولايات المتحدة.ولهذا السبب يرى أن امتلاك الولايات المتحدة لأقوى اقتصاد وأقوى جيش في العالم لا يُعفي مؤسساتها الثقافية والتعليمية التي يصفها بـ "روح أميركا" من خضوعها "للفساد اليساري"، وأنه لا تكفي القوة العسكرية والثروة العالمية وحدهما للحفاظ على مبادئ أميركا التأسيسية، ومن ثم فإن الحل من وجهة نظره يكمن في "الهزيمة الحاسمة لليسار، لا يمكن، ولن تتمكن أميركا من البقاء على قيد الحياة بطريقة أخرى".بل يذهب هيغسيث إلى أبعد من ذلك في كتابه هذا، ويعلن أن الحل الشامل للفترة الحالية من التاريخ الأميركي "تستدعي حملة أميركية صليبية. نعم، حرب مقدسة من أجل قضية الحرية الإنسانية العادلة".وفي الكتاب ذاته يكشف وزير الدفاع الأميركي هيغسيث عن موقفه تجاه الإسلام صراحة، ونراه لا يختلف كثيرا عن كتابه السابق "في الميدان" فهو يرى أن "الإسلاموية المستمدة مباشرة من الإسلام والقرآن، هي النظرة العالمية الأكثر تماسكا وانتشارا، بل والأكثر عدوانية على كوكب الأرض اليوم".ومن هذا المنطق فهو يرى أن ما وصفهم بالمسلمين المعتدلين "لا يحاربون الإسلاميين فحسب، بل يحاربون أيضًا الجزء الأعظم من العقيدة والتاريخ والتقاليد الإسلامية، وإن جوهر الإسلام الحقيقي أقرب إلى الإسلاميين منه إلى المعتدلين".وكما دعا إلى إعمال الروح الصليبية الكامنة في المجتمع الأميركي للتخلص من لوثة اليسار المستولي على روح أميركا في مؤسساتها الثقافية والتعليمية والسياسية، فإن الأمر عينه يجب أن يحصل مع من وصفهم بالإسلاميين.يقول في موضع آخر: "كما تصدى الصليبيون المسيحيون الأوائل جحافل المسلمين في القرن الثاني عشر، سيحتاج الصليبيون الأميركيون اليوم إلى استجماع الشجاعة نفسها ضد الإسلاميين… فإلى جانب الشيوعيين الصينيين وطموحاتهم العالمية، تُعدّ الإسلاموية الخطر الذي يتهدد الحرية في العالم".ولهذا السبب يرى هيغسيث أن المعركة صفرية "لا يمكن التفاوض معها (أي الإسلاموية) أو التعايش معها أو فهمها، بل يجب تهميشها وسحقها".أما الأمر الذي أثار الجدل في أواخر مارس/آذار الماضي وسط هذه الغابة من التصريحات والأفكار، حين ظهر وزير الدفاع الأميركي في أثناء زيارته إلى قاعدة بيرل هاربر-هيكام الجوية والبحرية، وفيها شارك مع الجنود في تدريبات اللياقة البدنية، وقد أظهرت إحدى الصور وَشما على ذراع هيغسيث يحمل كلمة "كافر" مكتوبة باللغة العربية خلال مشاركته في التدريبات مع الجنود.كما ظهرت أسفل كلمة "كافر" عبارة "Deus Vult" باللاتينية التي تعني "إرادة الإله"، وهي الكلمة التي كانت شعارا لعامة الناس من الأوروبيين المتحمسين حين أعلن البابا أوربان الثاني عام 1095 انطلاقة الحملات الصليبية على العالم الإسلامي في مجمع كليرمونت بوسط فرنسا، وهو الأمر الذي يؤكد أن هيغسيث متشبع بعصر الحروب الصليبية على الشرق الإسلامي بحمولاته الثقافية والعقدية إلى حد الثُّمالة.وإذا كانت مواقف هيغسيث من الإسلام والإسلاميين والتاريخ الإسلامي متشددة إلى هذه الدرجة، فإن نظرته إلى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لا تقل حدة، إذ يعتبر هيغسيث إسرائيل "حليفا إستراتيجيا لا غنى عنه" للولايات المتحدة، ويدعم بقوة سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقد زار إسرائيل عدة مرات حيث رصدت الصحافة الإسرائيلية أهم تصريحاته، ففي الزيارة الأولى التي قام بها في يونيو/حزيران 2016 والتقى أثناءها بعدد من كبار الشخصيات الإسرائيلية في فندق الملك داود في القدس ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن معلق قناة فوكس نيوز الأميركي وقتئذ هيغسيث انتقد حينها السياسة الأميركية في الشرق الأوسط بزعامة باراك أوباما، ودعا إلى ضرورة الاقتداء بإسرائيل قائلا: "أميركا قادرة على التعلم من إسرائيل" وهو العنوان الذي وضعته الصحيفة في صدارة تقريرها.وقصد هيغسيث من وراء تصريحه ذلك بحسب جيروزاليم بوست إلى أن تدرك الولايات المتحدة الأميركية القيم التي تتمتع بها إسرائيل، مثل إدراك الحاجة إلى "الدفاع الجماعي"، أو ثقافة امتلاك الجميع للسلاح، وامتلاك ثقافة واقتصاد قويين، "هي شيء يمكن للولايات المتحدة أن تتعلم منه" بحسب وصفه.هذا الإلهام الإسرائيلي الذي اقتنع به هيغسيث جعله في زيارته الثانية لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وأثناء الفترة الرئاسية الأولى لزعيمه المفضل دونالد ترامب لأميركا يعلن صراحة أنه "لا يوجد سبب يمنع إعادة بناء الهيكل"، وأن لشعب إسرائيل الحق الكامل في "أرض إسرائيل والحرم القدسي".أبدى هيغسيث في هذه الزيارة تبنيًا للرواية الصهيونية بحذافيرها، فقد وصف الأراضي الفلسطينية المحتلة بيهودا والسامرة، ورأى أن المعجزات التي تحققت في تاريخ إسرائيل الحديث في إبان النشأة والظهور والانتصارات العسكرية التي حققتها واردة التكرار.يقول: "كان عام 1917 معجزة، وعام 1948 معجزة، وعام 1967 معجزة، وفي عام 2017، كان إعلان القدس عاصمة لإسرائيل معجزة، ولا يوجد سبب يمنع معجزة إعادة بناء الهيكل في الحرم القدسي الشريف. لا أعرف كيف سيحدث، وأنتم لا تعرفون كيف سيحدث، لكنني أعلم أنه ممكن، هذا كل ما أعرفه".وختم هيغسيث حديثه قائلا: "إحدى خطوات هذه العملية هي الاعتراف بأهمية الحقائق والأنشطة على الأرض. لهذا السبب، فإن زيارة يهودا والسامرة، مع إدراك أن السيادة على الأراضي الإسرائيلية ومدنها ومواقعها، هي خطوة حاسمة لكي نثبت للعالم أن هذه الأرض هي أرض اليهود، وأرض إسرائيل".وخلال جلسة استماع تأكيد ترشيحه لمنصب وزير الدفاع في 14 يناير/كانون الثاني 2025، أعرب هيغسيث عن دعمه القوي لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، قائلا: "أدعم إسرائيل في تدمير وقتل كل عضو من حماس".وعندما سُئل عما إذا كان يعتبر نفسه "صهيونيًا مسيحيا"، أجاب هيغسيث: "أنا مسيحي وأدعم بقوة دولة إسرائيل ودفاعها الوجودي، والطريقة التي تقف بها أميركا بجانبها كحليف عظيم".وفي مقابلة لاحقة مع قناة فوكس نيوز بتاريخ السادس من فبراير/شباط 2025، ناقش هيغسيث اقتراح الرئيس ترامب بإمكانية تدخل الولايات المتحدة في غزة لإعادة إعمارها، مشيرًا إلى أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".ورغم قصر عُمر هيغسيث في وزارة الدفاع الأميركية، ورؤيته اليمينية المتشددة في كتبه ومقابلاته كما مرّ بنا، فإن سلسلة من التصريحات والأفكار الصادمة واللافتة لا يكفيها حجم هذا التقرير، فهو يؤمن بأن "أميركا قوية من جديد" تعني أن مصالحها مقدمة على مصالح الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بل والمؤسسات الدولية كافة.وهو يتشكك في قضايا المناخ واتفاقياته، ويرى أن المصالح الأميركية الاقتصادية مقدمة على هذا الأمر.كما يؤمن بأمور أكثر غرابة من ذلك، ففي عام 2019 قال إنه لم يغسل يديه منذ 10 سنوات، بل ولا يعتقد بوجود الجراثيم، وهو ما أثار انتقادا واسعًا حينها، وجاء اعتراف هيغسيث خلال نقاش في برنامجه حول تناوله شريحة بيتزا بقيت خارج الثلاجة ليوم كامل، وهو أمر لم يرَ فيه أي مشكلة على الإطلاق.

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الأربعاء- أن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية يونيو/حزيران المقبل، مضيفا أن بعض دول الشرق الأوسط قد تعترف بدورها بإسرائيل.وقال خلال مقابلة على قناة فرانس 5: "علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بالدولة الفلسطينية)، وسنفعل ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا أفعل ذلك لإرضاء أحد. سأفعله لأنه سيكون مناسبا في وقت ما".وأضاف "ولأنني أيضا أرغب في المشاركة في جهود جماعية تمكن المدافعين عن فلسطين من الاعتراف بإسرائيل بدورهم، وهو أمر لا يفعله كثيرون منهم".وحصلت الدولة الفلسطينية على اعتراف ما يقرب من 150 دولة رغم أن معظم القوى الغربية الكبرى لم تتخذ تلك الخطوة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

وقّع العراق اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مشروعات تشمل محطات كهرباء بقدرة 24 ألف ميغاوات، وذلك خلال زيارة وفد تجاري أميركي يمثل أكثر من 60 شركة إلى بغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان أن وزارة الكهرباء العراقية وشركة "جي إي فيرنوفا" وقعتا مذكرة تفاهم تشمل مشاريع لمحطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميغاوات"، مشيرا إلى "إمكانية تأمين توفير التمويل الخارجي من البنوك العالمية".ورعى السوداني اليوم كذلك مراسم توقيع "مذكرة ثانية تضمّنت مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء ومجموعة "يو جي تي رينيوابلز" الأميركية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة 3 آلاف ميغاوات"، بالإضافة إلى "إنشاء ما يصل إلى ألف كيلومتر من البنية التحتية الجديدة لنقل التيار المباشر العالي الجهد".ووقّع اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأميركية مذكرة تفاهم "لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاونية والعلمية والتكنولوجية القائمة".وأجرت بعثة من نحو 60 شركة أميركية -وهي "أكبر بعثة تجارية أميركية- زيارة إلى العراق من الاثنين حتى الأربعاء لتوقيع عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص.وقال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين إن الحكومة العراقية "وضعت خططا لتحقيق استقلالية وتلبية احتياجات الشعب العراقي من الكهرباء المستقرة وغير المنقطعة".وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقّعها العراق مع "جي إي فيرنوفا" تعكس "العلاقة المستدامة مع الشركات الأميركية التي يمكنها توفير الخبرات والخدمات التي يحتاج إليها العراق". وأضاف أن "العراق أرض فرص للشركات الكبرى للعمل والاستثمار فيها".وألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي إعفاء من العقوبات سمح للعراق منذ 2018 بسداد ثمن الكهرباء لإيران، وذلك في وقت تواصل فيه واشنطن حملة "أقصى الضغوط" على طهران.ويستخدم العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، واردات الطاقة الإيرانية لتوليد الكهرباء، ويتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لتقليل اعتماده على واردات الطاقة والغاز من إيران.

يثير تعيين شركة "ميتا" لأعداد كبيرة من الجنود السابقين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي تساؤلات خطيرة حول التزام العملاق التكنولوجي بحرية التعبير، ويكشف لمحة عن عملية تحيُّز في مراقبة المحتوى أدت إلى حذف آلاف الحسابات المؤيدة لفلسطين خلال الحصار وحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.في تقرير له، يذكر موقع "غراي زون" الأميركي، أن أكثر من 100 جاسوس وجندي سابق في الجيش الإسرائيلي يعملون في شركة "ميتا"، وخدموا في الجيش الإسرائيلي عبر برنامج حكومي يسمح لغير الإسرائيليين بالتطوع في الجيش.أبرز هؤلاء، المحامية الأميركية في مجال الحقوق الدولية، شيرا أندرسون، وهي رئيسة سياسة الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، والتي تطوّعت للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي عام 2009 عبر برنامج "جارين تسابار" المخصص لليهود غير الإسرائيليين غير الخاضعين للتجنيد الإلزامي.ومن خلال هذا البرنامج، تورّط العديد من غير الإسرائيليين الذين حاربوا مع الجيش الإسرائيلي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.خدمت أندرسون كضابط صف في الجيش الإسرائيلي لأكثر من عامين، حيث عملت في قسم المعلومات الإستراتيجية العسكرية، وكتبت تقارير دعائية للجيش. كما كانت حلقة وصل بين الجيش والبعثات العسكرية الأجنبية في إسرائيل، وبين الجيش والصليب الأحمر.مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي للشركات التكنولوجية والجيوش، فإن دور أندرسون في "ميتا" حاسم، فهي تُطور الإرشادات القانونية وسياسات الذكاء الاصطناعي ورسائل العلاقات العامة المتعلقة بتنظيم هذه التكنولوجيا في جميع مجالات "ميتا"، بما في ذلك فرق المنتجات والسياسة العامة.ليست أندرسون الوحيدة في "ميتا" من خلفية عسكرية إسرائيلية، حيث كشف تحقيق جديد عن وجود أكثر من 100 جاسوس وجندي إسرائيلي سابق في الشركة، كثيرون منهم عملوا في وحدة 8200 الاستخباراتية الإسرائيلية. ويتوزع هؤلاء الموظفون بين مكاتب "ميتا" في الولايات المتحدة وتل أبيب، ويتمتع عدد كبير منهم بخبرة في الذكاء الاصطناعي.وبالنظر إلى استخدام إسرائيل المكثّف لهذه التكنولوجيا في تنفيذ الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والمراقبة، فإن تعيين "ميتا" لمتخصصين إسرائيليين في الذكاء الاصطناعي يثير قلقا بالغا.يتساءل الموقع: هل تعاون هؤلاء الجواسيس السابقون مع الجيش الإسرائيلي لإنشاء قوائم اغتيال؟ ويجيب أنه وفقا لتقرير سابق، اخترقت وحدة 8200 مجموعات واتساب ووضعت أسماء جميع الأعضاء في قوائم استهداف إذا كان أحد الأعضاء يُشتبه بانتمائه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بغض النظر عن حجم المجموعة أو محتواها.هناك أسئلة خطيرة حول جرائم حرب تحتاج "ميتا" للإجابة عنها، وهي أسئلة ربما صاغت أندرسون ردودا "علاقات عامة" عليها مسبقا.لأندرسون تاريخ طويل في الولاء لإسرائيل، حيث انضمت إلى الجيش الإسرائيلي بعد دراسة التاريخ في جامعة كاليفورنيا-بيركلي، ثم حصلت على درجة القانون من جامعة ديوك قبل العودة إلى إسرائيل للعمل في مركز أبحاث يديره رئيس الجيش السابق.كما عملت مساعدة قانونية لرئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، التي رفضت قبل أسبوعين التماسا لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، ما يشكّل تشريعا لاستخدام الجوع كسلاح، وهي جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف.أندرسون نفسها تُنكر الإبادة الجماعية بشكل صارخ. فخلال ظهورها في بودكاست عام 2023، قالت "أرفض تماما فكرة حدوث إبادة"، ونفت استهداف إسرائيل للمدنيين عمدا، واصفة حماس بـ"طائفة الموت"، وغزة بـ"الدولة الفاشلة" (رغم أنها ليست دولة)، وهي نقطة جوهرية في فهم المقاومة الفلسطينية، وكان من المفترض أن تعرفها محامية حقوق إنسان دولية.كما أشارت إلى أن "القانون الدولي لا يسمح لإسرائيل بفعل ما تفعله في غزة" وفي الضفة الغربية المحتلة، معربةً عن أسفها لأن "قواعد مختلفة تنطبق هناك"، وهاجمت الصليب الأحمر لـ"تصرفه كدولة" في إسرائيل.طريق أندرسون إلى الجيش الإسرائيلي عبر برنامج "جارين تسابار" مثير للجدل أيضا، إذ مكّن هذا البرنامج غير الإسرائيليين (المعروفين بـ"الجنود الوحيدين") من الانضمام للجيش وارتكاب جرائم حرب قبل العودة إلى بلدانهم.وتُنظر حاليا دعاوى قضائية في عدة دول ضد متطوعين في البرنامج، بما في ذلك في بريطانيا حيث قُدِّمت أدلة في لندن على جرائم حرب ارتكبها 10 بريطانيين خلال خدمتهم في الجيش الإسرائيلي.بعض الجواسيس السابقين في "ميتا" خدموا لسنوات في وحدة 8200 الإسرائيلية، مثل غاي شينكرمان (10 سنوات في الوحدة قبل الانتقال إلى "ميتا" عام 2022)، وميكي روتشيلد (قائد في فرقة الصواريخ الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية)، وماكسيم شموكلر (6 سنوات في الوحدة 8200 قبل العمل في "ميتا" ومنصات أخرى)، بحسب "غراي زون".وبينما ينتمي هؤلاء إلى الجيش الإسرائيلي، تطوّعت أندرسون لاستخدام مهاراتها القانونية لتبييض جرائم إسرائيل.ويأتي هذا الكشف بعد تحقيقات سابقة عن توغل جواسيس إسرائيليين سابقين في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "غوغل"، إذ يشير انتشارهم إلى سيطرة الأصوات الموالية لإسرائيل على الدولة الأميركية.. أصوات تُنكر الإبادة بينما يُحرق الصحفيون في الخيام، وتُرفع جثث الرُضّع المشوّهين فوق أنقاض غزة، وتُشرعن المجاعة.مع تقدم عصر الذكاء الاصطناعي، يُحدّد مستقبلنا أشخاص بنوا أنظمة مراقبة ساعدت في إبادة الفلسطينيين. فهل نسمح لهم بفرض رؤيتهم على العالم؟ يتساءل تقرير "غراي زون".

على غرار عملية "السور الحديدي" التي أطلقتها إسرائيل ضد مخيمات جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي دخلت شهرها الثالث، وبعد عشرات الاقتحامات لمخيمات "بلاطة" و"عسكر" و"العين" في نابلس، شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة على مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة نابلس، فجر اليوم الأربعاء.وذكر بيان مشترك للمتحدثين باسم جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية أن "عملية واسعة النطاق" بدأت في نابلس شمال الضفة الغربية. في حين ذكرت القناة (12) الإسرائيلية أن وحدتين خاصتين ونحو 3 كتائب إضافية بدأت عمليتها بمخيم بلاطة ضمن العملية بشمال الضفة الغربية.وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر من عملية مماثلة استهدفت مخيم العين غربي نابلس، استمرت لعدة ساعات، نزحت خلالها أكثر من 40 أسرة، وهدد الاحتلال بهدم نحو 80 منزلا في المخيم.ومن محاور مختلفة من جنوب المدينة وشرقها، اقتحم جيش الاحتلال مخيم بلاطة بعشرات الآليات العسكرية ودوريات المشاة الراجلة، وتوغل في معظم أحيائه لا سيما حارة "الجماسين" ومنطقة "شارع السوق" وسط المخيم، ومن ثم توسعت الاقتحامات لتطال حارات أخرى، وتخلل ذلك مداهمات للبيوت وعمليات تفتيش عنيفة وتنكيل بالمواطنين.ومع بداية العملية طرد جنود الاحتلال 3 عائلات من منازلهم في حارة الجماسين إلى خارج المخيم، وحولوها لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني، وأعلنوا عبر مكبرات الصوت فرض حظر التجوال على المخيم.وأدت الإجراءات التي فرضتها قوات الاحتلال إلى إصابة 3 مواطنين على الأقل بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق الشديد بالغاز المسيل للدموع، في حين استهدف الجنود الصحفيين بقنابل الغاز، وعرقلوا عمل الطواقم الطبية.وقال رئيس لجنة خدمات مخيم بلاطة عماد زكي إن "العملية العسكرية لا تزال مستمرة، وإن الجيش أبلغ مواطنين خلال اقتحام منازلهم أنها ستستمر ليومين أو ثلاثة، لكننا بلغنا من جهات رسمية أنها ستستمر حتى صباح غد الخميس".وأوضح زكي في حديثه للجزيرة نت أن هذه العملية تختلف عن الاقتحامات السابقة، سواء من حيث الانتشار الكبير لمئات الجنود بين الأزقة، أو باقتحام المنازل وتفتيشها بشكل عنيف ودقيق جدا بأسلوب "من بيت لبيت"، أو بالتحقيقات الميدانية مع العديد من العائلات التي اقتحموا منازلها واعتقلوا شبابها، "ومن يعتقلونه من الشبان ويطلقون سراحه يبعدونه عن المخيم ويمنعون عودته إليه" حسب قوله.وذكر زكي أن الجيش أطلق الطائرات المسيّرة للقيام بعمليات البحث والتفتيش داخل أزقة المخيم، وأضاف أن "من يجدون لديه علم فلسطين أو حتى لعب الأطفال -من قبيل أسلحة البلاستيك- ينكلون به ويعتدون عليه، ويقلبون منزله رأسا على عقب، حتى خزانات المياه على أسطح المنازل يفتشونها"."كما يظهر من العملية أنها ذات طابع انتقامي من أهالي المخيم، أكثر من أنها تهدف لتدمير الشوارع والبنية التحتية كما فعل الاحتلال بمخيمات جنين وطولكرم" حسب زكي. ويقول "لا يوجد بمخيم بلاطة ما يستدعي عملا عسكريا كبيرا كباقي المخيمات، ونحن قدمنا احتجاجا للقناصل الأوروبيين على عملية الاحتلال، وطالبنا الأهالي بأن لا يستجيبوا لأية أوامر نزوح".وفرض الجيش الإسرائيلي حصارا مطبقا على جزء كبير من حارات المخيم، وبصعوبة بالغة استطاع الأهالي إخراج بعض الحالات المرضية كمرضى غسيل الكلى والسرطان لتلقي العلاج.وقال المواطن والصحفي جمال ريان، من مخيم بلاطة، للجزيرة نت إن "عددا كبيرا من الجنود اقتحموا منزله في حارة مغدوشة بمخيم بلاطة، واحتجزوا أطفاله بغرفة لوحدهم، وأجروا معه تحقيقا ميدانيا قبل أن يقوموا بتفتيش المنزل بشكل كامل والعبث بمحتوياته"، وأضاف "حطموا الكاميرات الخاصة بي وعدة التصوير كاملة، وكسروا أبواب الغرف".وذكر ريان أن جيش الاحتلال كان يطلق الطائرات المسيرة قبل اقتحامه أي زقاق أو منزل، حيث تقوم المسيرات بإجراء كشف كامل مسبقا، "وأحيانا يطلقون هذه الطائرات داخل المنازل عبر النوافذ" وفق روايته.بدوره، شدد محافظ نابلس غسان دغلس، في تصريحات صحفية خلال زيارته لمخيم بلاطة عقب اقتحامه "موجودون هنا بين أهلنا ولن نبرح المكان، وما يصيب الأهالي يصيبنا".ووصف ما يقوم به الاحتلال بـ"سياسة فاشلة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، ضمن صمت عربي ودولي ينظر ولا يحرك ساكنا"، وأضاف "نحن اليوم وبهذه المرحلة نشكل وحدة حال مع أهلنا بالميدان، لنفوت الفرصة على الاحتلال".وذكر دغلس أن الاحتلال يشن "حرب إبادة" ضد الشعب الفلسطيني، وتابع "نريد أن نحافظ على هذه الأجيال ولا نخسرها، نحن أصحاب الأرض والوطن، ونقول للعالم استيقظ، هذا الشعب يصل لـ5 ملايين نسمة، لا يمكن اجتثاثه من أرضه".يُذكر أن مخيم بلاطة الذي يقطنه أكثر من 33 ألف لاجئ، ويوصف بأنه أكبر مخيمات الضفة الغربية، تعرض بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول لعشرات الاقتحامات كمخيمات ومدن وقرى الضفة الغربية، وقتل الاحتلال نحو 30 مواطنا فيه، وهجر عائلات كثيرة، بعد أن استهدف نحو 200 منزل بالهدم والتدمير الجزئي والكامل.ولا تزال قوات الاحتلال موجودة حتى الآن في مخيمات جنين وطولكرم، بعد أن هجَّرت سكانها بالكامل، خاصة مخيم جنين الذي هدمت فيه مئات المنازل وقتلت عشرات المواطنين، وتسببت بنزوح نحو 50 ألف مواطن، وفق بيانات اللجان الخدمية بتلك المخيمات.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأربعاء- إنه سمح بوقف مؤقت مدته 90 يوما، في إطار خطته للرسوم الجمركية، لكنه رفع كذلك نسبة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% تسري على الفور، بعدما كانت 104%.وأضاف ترامب أنه "أذن بتعليق لمدة 90 يومًا، وتخفيض كبير في التعرفة المتبادلة خلال هذه الفترة، بنسبة 10%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورا".وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه قرر وقف الرسوم الجمركية المضادة 90 يوما عن الدول التي لم ترد على الرسوم الأميركية، في حين زاد الرسوم على الصين التي أعلنت مزيدا من الإجراءات الانتقامية.وأقر ترامب بأن الناس يشعرون ببعض الخوف من الرسوم الجمركية، مجددا الإشارة إلى قناعته بإمكان التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول في نهاية المطاف، بما في ذلك الصين.وقال: "الصين ترغب في إبرام اتفاق. لكنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك، الرئيس شي جين بينغ رجل معتز بنفسه، إنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك لكنهم سيجدون حلا".في السياق، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -اليوم الأربعاء- إنه يعتقد أن إدارة ترامب يمكنها التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع حلفاء الولايات المتحدة.يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بيسنت لقيادة مفاوضات مع أكثر من 70 دولة خلال الأسابيع المقبلة، محذرا من أن التحركات للتقارب على نحو أوثق مع الصين قد تأتي بنتائج عكسية.وقال بيسنت -خلال مؤتمر لجمعية المصرفيين الأميركيين في واشنطن- إنه سيضطلع بدور تفاوضي رئيسي في المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب.وأضاف أنه على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية "قالت الشركات -التي تحدثت معها عموما- والوافدون، وأعني الرؤساء التنفيذيين، الذين جاؤوا إلى وزارة الخزانة، إن الاقتصاد قوي للغاية".تسببت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب، والتي يقول إنها تهدف إلى القضاء على العجز التجاري للولايات المتحدة مع كثير من البلدان، في قلب نظام التجارة العالمي رأسا على عقب، مما أثار مخاوف من حدوث ركود وأدى إلى خسارة شركات كبرى تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية.وشهدت الأسواق العالمية مزيدا من التراجع اليوم مع سريان الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على البضائع الصينية بنسبة 104%، بينما أثارت موجة بيع حادة في السندات الأميركية مخاوف من هروب التمويل الأجنبي من الأصول الأميركية.وقال بيسنت إن هناك اهتماما كبيرا بالتفاوض مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن ترامب تحدث بالفعل مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية، وإن مسؤولين أميركيين سيلتقون وفدا من فيتنام اليوم.وأضاف "أعتقد… أننا قد نتمكن في نهاية المطاف من التوصل إلى اتفاق مع حلفائنا، ومع الدول الأخرى التي كانت… من الحلفاء العسكريين الجيدين، لكنها ليست من الحلفاء الاقتصاديين المثاليين. ومن ثم، يمكننا التعامل مع الصين وكأنها مجموعة".وأضاف أن الرسوم الجمركية المضادة الشاملة التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي تمثل سقفا للرسوم الجمركية إذا لم ترد الدول، لكن الصين لم تستجب لهذه النصيحة.وتابع "في ما يتعلق بالتصعيد، لسوء الحظ، فإن أكبر مرتكبيه في النظام التجاري العالمي هو الصين، وهي الدولة الوحيدة التي قامت بالتصعيد".

قبل شهرين تقريبا، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني من غزة إلى دول مجاورة بحجة استحالة العيش فيها بعد الدمار الواسع الذي ألحقته بها إسرائيل، وتحويل المنطقة المحاصرة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مثيرا "صدمة" في المنطقة والعالم، وتساؤلات عن قابلية الخطة للتطبيق.وعلى الرغم من تراجع حالة الصخب التي أثارها إقليميا ودوليا، تستمر ارتدادات المقترح مع استئناف إسرائيل الحرب على القطاع في 18 مارس/آذار بشراسة أكبر وبدعم أميركي صريح، وتحت عنوان كبير، وهو الضغط على حركة حماس لحملها على تقديم تنازلات في ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها.وعلى مدى أسابيع، تواترت تصريحات ترامب وعكست ما بدا تصميما منه على إنفاذ خطة "إعادة توطين" فلسطينيي غزة وجعل المنطقة ملكية أميركية طويلة الأجل، وصدرت أحدث التصريحات الثلاثاء حين وصف غزة بأنها "منطقة عقارات مهمة ورائعة"، قائلا إن وجود "قوة سلام" هناك كالولايات المتحدة تسيطر وتمتلك القطاع سيكون أمرا جيدا، وفق تعبيره.بيد أن الرئيس الأميركي بدا قبل ذلك، في فبراير/شباط ثم في مارس/آذار، وكأنه تراجع خطوة للوراء عن خطته لطرد فلسطينيي غزة من دون إمكانية العودة إليها، حين قال إنه لن يفرضها وسيكتفي بالتوصية بها، وإن أحدا لن يُطرد من القطاع، بعد أن كان يقول إن الولايات المتحدة ستسيطر على القطاع وسيرحل سكانه إلى مصر والأردن.وربما خلص ترامب إلى هذا الاستنتاج بعد أن عاين رفض مبدأ التهجير الذي عبّرت عنه الدول العربية مجتمعة في قمة القاهرة التي عقدت في الرابع من مارس/آذار، وشهدت إقرار الخطة المصرية لإعادة قطاع غزة بقيمة 53 مليار دولار، وذلك ضمن موجة من الاستهجان الدولي لهذا المقترح (مقترح ترامب) الذي وصفته دول وهيئات دولية بأنه مناف للقوانين الدولية.وكانت مصر والأردن -المستهدفتان مباشرة بفكرة إعادة التوطين- قد رفضتا بشدة مرارا المقترح الأميركي الذي لقي أيضا معارضة كبيرة من قوى غربية أخرى عديدة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه ومن الأمم المتحدة.ومع أنه لم يصدر حتى الآن تصريح رسمي بالتراجع عن المقترح، إلا أن بعض التقارير الإعلامية تنسب إلى مقربين من الرئيس الأميركي أنه تخلى عن مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط" في غزة، ولعلّ موقفه المعدّل الذي عبر عنه في مارس/آذار بعدم طرد أحد من سكان القطاع، كان مدفوعا بآراء من داخل إدارته بعدم واقعية مقترح إعادة التوطين.وفي المقابل، سارع الإسرائيليون لالتقاط المقترح ورأوا فيه فرصة سانحة للتخلص من "صداع غزة"، خاصة في ظل الدعم المطلق من الإدارة الجمهورية الحالية.وبالنسبة إلى المحللين، فإن خطة ترامب، محكوم عليها بالفشل، أو هي تواجه -في الحد الأدنى- تحديات كبيرة، على الرغم من أن إسرائيل تحاول من خلال التصعيد الحالي أن تجد سبيلا لتنفيذها عن طريق المجازر، ما أمكنها ذلك.في أوائل فبراير/شباط الماضي، فاجأ الرئيس الأميركي العالم، وحتى كثيرين داخل إدارته، حين طرح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض نقل سكان غزة إلى مصر والأردن، وذلك تحت دعاوى "إنسانية" مفادها إخراجهم من الجحيم إلى رغد العيش في أمكان أخرى.وأعاد مقترح دونالد ترامب بتهجير سكان غزة بذريعة إعادة إعمارها و"لتصبح منتجعا ساحليا دوليا تحت السيطرة الأميركية" فكرة سبق أن طرحها صهره جاريد كوشنر قبل عام.فقد قال كوشنر عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إنه "نزاع عقاري"، كما أن ترامب -الذي هو في الأصل من أثرياء العقارات- تحدث مرارا عن القطاع باعتباره "فرصة عقارية رائعة" عندما تسيطر عليه الولايات المتحدة.وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس عندما عرض خطته بشأن غزة، صدم مسؤولين كبارا في البيت الأبيض والحكومة.ومارس ترامب ضغوطا كبيرة على مصر والأردن لتقبلا بالمقترح، وبدا "واثقا" من أنهما ستقبلان بفكرة توطين مئات الآلاف من المهجرين من غزة، لكن القاهرة وعمّان لم ترضخا على الرغم من أنهما واجهتا تلويحا بتعليق المساعدات الأميركية الحيوية المقدرة بمليارات الدولارات.ويرى محللون أن خطة ترامب لتهجير غزة والاستيلاء فشلت حتى الآن، أو هي في طريقها لذلك، لأنها في الأساس غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ لأسباب من أهمها وجود "جدار صد" عربي، وهو ما عبرت عنه مصر والأردن منفردتين والدول العربية مجتمعة في قمة القاهرة.فمن دون تعاون الدول العربية، لا يمكن أن تنفذ الخطة، وذلك لأن هذه الدول ترى في تهجير الفلسطينيين إليها تهديدا لأمنها القومي، فضلا عن أن ذلك سيكون تصفية للقضية الفلسطينية.وهناك عامل أخرى مهم -بحسب المحللين- وهو رفض فلسطينيي غزة للتهجير، وصمودهم على أرضهم، وهو ما عبروا عنه في خيامهم المتهالكة، على الرغم من المجازر التي ترتكب ضدهم وتدمير أجزاء كبيرة من القطاع خلال الحرب.وفي السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إن ما يتحدث عنه الرئيس الأميركي بشأن غزة لا يعد مشروعا، ويضيف أنه لا توجد حتى الآن أي خطوات عملية باتجاه تنفيذ الخطة، وأن كل ما يقال عن استضافة بعض الدول للفلسطينيين المهجرين لا يتجاوز الأحاديث المتفرقة.ويتابع المحلل الفلسطيني -في حديث للجزيرة نت- أنه لا توجد رؤية أميركية واضحة في التعامل مع هذا الملف، وشبّه ما يجري الحديث عنه بإنشاء إدارة جو بايدن السابقة رصيفا عائما في غزة لتقديم المساعدات، ويعتبر أن ما يجري الآن ربما يكون امتدادا لتلك التجربة الفاشلة.ويقول القرا إن هناك رفضا فلسطينيا وعربيا لهذا المشروع، ويصف الموقف الفلسطيني منه بالحاسم، كما يصف موقف مصر بأنه يتسم بصلابة واضحة، إذ اتخذت القاهرة خطوات فعلية لمنع التهجير، منها الإصرار على إغلاق معبر رفح في حال وجود تدخل إسرائيلي فيه، وعدم القبول بفرض حلول تتعارض مع السيادة الفلسطينية.ويوضح أن الخطة العربية لإعمار غزة أثّرت بشكل ما على حماس واشنطن للمضي في خطوات عملية لتنفيذ مخطط التهجير.كما يعتبر القرا أن الرؤية الأميركية لما يسمى ريفييرا الشرق الأوسط غير منطقية وغير قابلة للتطبيق، وتظهر أن الرئيس الأميركي وإدارته لا يدركان واقع غزة الحقيقي ربما نتيجة التضليل الإسرائيلي، أو بسبب طريقة تفكير ترامب التي لا تزال تجارية.ويقول القرا إنه حتى لو حدث خروج للسكان من غزة، فسيكون محدودا لأسباب فردية تتعلق بمصالح شخصية كالسفر أو الدراسة أو العمل أو العلاج، وليس بدافع ترك القطاع، ويشير إلى أن إسرائيل تستغل هذا الوضع لتنفيذ خطوات تهدف للتهجير مثل ما يحدث حاليا في رفح.من جانبه، يرى مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي والكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية، أن المشروع الأميركي بشأن غزة لم يفشل بالكامل ولكنه يواجه تحديا كبيرا.ويقول إبراهيم -في حديث للجزيرة نت- إنه لا يمكن الجزم بفشل المشروع لأن هناك محاولات إسرائيلية مستمرة لتحقيق الهدف منه، ولكن في المقابل هناك أيضا إصرار فلسطيني على الصمود ومواجهة هذا المخطط الذي يروج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ويضيف أنه لعدم السماح بتمرير الخطة، يجب أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد، وموقف عربي أقوى، خاصة من خلال الضغط على الولايات المتحدة.ويشير المحلل الفلسطيني إلى أنه على الرغم من أن الموقف من خطة التهجير يعتبر إيجابيا حتى الآن، إلا أن هناك بعض التخوف من أن بعض الدول العربية قد تتساهل بهذا الشأن ولا تتخذ مواقف أكثر صلابة.وفي حديث سابق للجزيرة، قال حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي إن الشعب الفلسطيني بعث بعد وقف إطلاق النار (الذي خرقته إسرائيل) رسالة واضحة بأنه باقٍ في أرضه، مشيرا إلى أن الفلسطينيين سيفشلون هذه الخطة بدعم من الدول العربية.وفي غضون ذلك، جددت مصر اليوم الأربعاء رفضها لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء بشكل دائم أو مؤقت.يأتي ذلك بينما أعلنت الأمم المتحدة أن 400 ألف فلسطيني نزحوا داخل قطاع غزة منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية في 18 مارس/آذار.
قدم برشلونة أداء رائعا ليسحق ضيفه بوروسيا دورتموند 4-صفر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، اليوم الأربعاء.

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ على عشرات الشركاء التجاريين، وتبلغ نسبتها 104% على واردات المنتجات الصينية.

لندن- كلفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحالفا من محامين في لندن بتقديم طلب إلى وزيرة الداخلية البريطانية يفيت كوبر، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، لإزالة اسم الحركة من قائمة المنظمات المحظورة والمصنفة "إرهابية".وقُدِّم الطلب اليوم الأربعاء لمكتب الوزيرة، نيابة عن رئيس مكتب العلاقات الدولية في المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، بوصفه موكلا لتحالف "ريفير واي" للمحاماة الذي يضم عددا من مكاتب المحاماة و24 من الباحثين القانونيين والأكاديميين المستقلين.وكانت حركة حماس قد صُنّفت ضمن الجماعات المحظورة في بريطانيا يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من قبل وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل، بينما كانت كتائب القسام -الجناح المسلح للحركة- مدرجة في القائمة منذ مارس/آذار 2001.وترتب على هذا الحظر بشكل تلقائي عدد من الجرائم الجنائية المتعلقة بالجهة المحظورة، بما في ذلك العضوية بها، لكن يمتد هذا القرار أيضا ليشمل أي ناشط أو متظاهر قام بارتداء أو نشر رموز تابعة لها، أو عبّر عن دعمها أو الدعوة لها، أو نظم اجتماعات لدعمها، وهو ما وصفه المحامون بأنه مقيد لحرية التعبير في المملكة المتحدة، إذ تصعب مناقشة موضوع ساخن مثل القضية الفلسطينية دون خطر الوقوع بارتكاب جريمة.وحدث هذا بالفعل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ شهدت لندن عددا من الاعتقالات بموجب هذا القانون، بسبب رموز اعتُبرت أنها داعمة لعملية طوفان الأقصى مثل صورة المظلية "الباراشوت" التي استخدمت في العملية، إذ اعتقل من حمل هذه الصورة بموجب قانون الإرهاب وبتهمة "دعم جماعة إرهابية".تواصلت الجزيرة نت مع المحامين المكلفين بالقضية، وقال المحامي فرانك ماجينيس للجزيرة نت "كُلِّفتُ من حماس بتقديم طلب اليوم لوزيرة الداخلية، وطلبنا منها رسميا اتخاذ خطوة حاسمة نحو شطب حماس من قائمة المنظمات الإرهابية بموجب هذا الطلب".وفي بيانهم الصحفي، أشار تحالف المحامين إلى أن "استمرار حظر حماس يعني الدعم والتواطؤ في استعمار فلسطين والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة الصهيونية، وهذا يتعارض مع التزامات الدولة البريطانية بموجب القانونين الدولي والمحلي".وأوضح التحالف للجزيرة نت أن المعيار القانوني لحظر منظمة ما هو أنها "معنية بالإرهاب"، بينما تقول حماس إن "التعريف الواسع لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، يشمل أيضا جميع الجماعات والمنظمات حول العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك القوات الإسرائيلية والجيش الأوكراني والقوات المسلحة البريطانية نفسها، وبالطبع، ليست كل هذه الجماعات محظورة، حيث إن الأمر في النهاية يعد مسألة تقدير لوزيرة الداخلية".وحسب التوضيح، فإنه يتعين على وزيرة الداخلية أن تأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة، بما يشمل:ومع ذلك، "يجب أن تكون ممارسة سلطتها (وزيرة الداخلية) التقديرية عقلانية ومتسقًة مع الالتزامات المحلية والدولية الأخرى"، حسب وصفهم.أطلَع تحالف المحامين الجزيرة نت على وثيقة تشرح طلب فك الحظر، الذي يشير إلى أهمية الكفاح الفلسطيني، ويسلط الضوء على العناصر الرئيسية لتجربتهم مع العنف الصهيوني ومقاومتهم له.ويضم الطلب شهادات أساسية، بينها بيانان للدكتور موسى أبو مرزوق، يقدم الأول شرحًا لتاريخ حماس وآرائها حول عدد من القضايا، تشمل علاقتها ببريطانيا، و"معاداة السامية"، والصهيونية، والمقاومة، والتسوية السياسية المستقبلية.أما البيان الثاني، فهو شرح مفصل لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويتناول الاتهامات الموجهة لحماس في ما يتعلق بذلك اليوم، بالإضافة إلى العوامل التي شكلت الأساس المنطقي لعملية طوفان الأقصى، وفق رؤية الحركة: وهي انتهاك حرمة المسجد الأقصى، ومحنة الأسرى الفلسطينيين، وتطبيع العلاقات العربية والإسلامية مع إسرائيل.ويوضح البيان كيف سعت حماس إلى تحقيق أهداف عسكرية "محددة" خلال العملية، مع تعليمات مشددة بعدم استهداف النساء والأطفال وكبار السن، موضحا أن حماس مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأي طرف ثالث محايد لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث ذلك اليوم.كما تتضمن ملاحق طلب الحركة برفعها من قوائم الإرهاب أدلةً ومصادر أولية من حماس تقدم نظرة لطبيعة المنظمة المتغيرة، وتركيزها على بناء حكم رشيد للشعب الفلسطيني، في سياق استعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل.واستند هذا الطلب إلى خبرة 19 باحثا، ينتمون إلى خلفيات أكاديمية وصحفية وسياسية وثقافية متنوعة، استطاعوا تقديم 24 تقريرا تفصّل تاريخ وسياق تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، منذ أواخر القرن الـ19 وحتى الوقت المعاصر.وتضم قائمة الذين عملوا على إنجاز هذه التقارير مجموعة من الخبراء من بينهم:صرح الدكتور عاصم القرشي، وهو أكاديمي وباحث مشارك في تجهيز الطلب القانوني، للجزيرة نت بأن "أحد أهم جوانب الطلب، وحتى جميع تقارير الخبراء المرفقة، ترتكز على عنصر أساسي، وهو أن الحكومة البريطانية كانت متواطئة باستمرار مع نظام استيطاني استعماري".وأضاف القرشي أن "معظم دول العالم اعترفت بأن الكيان الصهيوني دولة استيطانية استعمارية، ومع ذلك لا يزال لدينا ديمقراطية عالمية وأوروبية تتواطأ مع هذا النظام، بل وتستمر بإرسال الأسلحة إليه رغم اتهامه بارتكاب إبادة جماعية".ويعتقد القرشي أنه حتى لو تم إخراج حماس من هذا الطلب، فإنه سيظل قائما، لأنه يتعلق بالعلاقة البريطانية مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري.كما أضيف إلى الطلب أيضا، طلب مشترك سابق قدمته مجموعة من كبار العلماء الأكاديميين المتخصصين في شؤون حماس والسياسة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، لإلغاء حظر حركه حماس، حيث طلب التحالف أن تعتبر حججهم صالحة وأن تأخذها وزيرة الداخلية الحالية بعين الاعتبار.قدم التحالف 3 أسباب رئيسية تدعو لإلغاء حظر حركة حماس، وهي:كما أكد التحالف أن حركة حماس تعد القوة العسكرية الفعالة الوحيدة التي تقاوم وتسعى إلى إنهاء ومنع أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المستمرة، التي ترتكبها الدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزة، معتبرين أن استمرار حظرها يعوق -بشكل متعمد وعملي- جهود الشعب الفلسطيني لاستخدام القوة العسكرية لإنهاء ومنع أعمال الإبادة الجماعية المستمرة بحقه.وبناء على ذلك، فإن هذا الحظر المستمر بحق حماس -حسب التحالف- ينتهك التزام بريطانيا باستخدام جميع الوسائل المتاحة بشكل معقول لمنع وإنهاء الإبادة الجماعية، كما يجعل بريطانيا متواطئة في أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.بدوره، أوضح المحامي دانيال غروتيرز من مكتب "وان بامب ستريت" للجزيرة نت -عقب تقديمه مباشرة- أن "الطلب الذي قُدم لوزيرة الدولة للشؤون الداخلية يستند إلى 3 محاور أساسية، ويدعو لإزالة حماس من قائمة المنظمات المحظورة أو المصنفة كإرهابية".وأضاف أن "الحجج تستند إلى قوانين حرية الخطاب والتعبير، والذي يشير إلى أن وصف المنظمة في فلسطين يعد موضوعا ذا أهمية سياسية هائلة، وهو محط نقاش عام، وبالتالي فإن الحظر يقيد خطاب الجمهور البريطاني لتناول قضية فلسطين في مناقشات عامة وحرة، وهو ما يعتبر تقييدا بموجب القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان".وأردف قائلا إن "القرار غير عملي أمام الجريمة الجماعية التي يتم ارتكابها ضد الفلسطينيين"، وأضاف "نحن جميعا نريد السلام في الشرق الأوسط، ولذلك نحتاج إلى الحديث، ليس فقط مع الأصدقاء بل حتى مع الأعداء"، مؤكدا أنه بموجب القانون فإن الرد ينبغي أن يكون في غضون 90 يوما، وأنهم يتطلعون لسماع رد الوزيرة.

أعلنت الصين اليوم الأربعاء أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34% كما كان مقررا، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين بكين وواشنطن.ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ على عشرات الشركاء التجاريين اليوم الأربعاء، وتبلغ نسبتها 104% على واردات المنتجات الصينية.وعارضت بكين باستمرار رفع الرسوم الجمركية وقالت اليوم الأربعاء إنها ستتخذ خطوات "حازمة وقوية" لحماية مصالحها.وقالت وزارة التجارة الصينية لاحقا في بيان إن "نسبة الرسوم الجمركية الإضافية" سيتم "رفعها من 34% إلى 84%" اعتبارا من الخميس الساعة 12:1 بالتوقيت المحلي (04:01 بتوقيت غرينتش).وأضافت الوزارة أن "تصعيد التعريفات الجمركية ضد الصين من قبل الولايات المتحدة يؤدي فقط إلى تراكم الأخطاء فوق الأخطاء وينتهك بشدة حقوق الصين ومصالحها المشروعة".وشددت على أن إجراءات واشنطن "تلحق ضررا خطيرا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد".وتعليقا على التطورات، قال كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول تشيوي تشانغ إن الصين "أرسلت اليوم إشارة واضحة مفادها أن الحكومة ستلتزم بموقفها بشأن السياسات التجارية".وتابع تشانغ "لا أتوقع مخرجا سريعا وسهلا من النزاع التجاري الحالي"، مضيفا أن "الأضرار على الاقتصادين ستصبح واضحة قريبا".في بيان منفصل اليوم، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستدرج 6 شركات أميركية للذكاء الاصطناعي على القائمة السوداء، من بينها شركتا "شيلد إيه آي إنك." و"سييرا نيفادا كورب".وجاء في البيان أن الشركات إما باعت أسلحة إلى تايوان وإما تعاونت في "التكنولوجيا العسكرية" مع الجزيرة.من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم إن تحرك الصين لفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 84% ضد الولايات المتحدة أمر مؤسف وخيار خاسر.وأضاف بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: "أعتقد أن عدم رغبة الصينيين فعليا في الحضور والتفاوض أمر مؤسف لأنهم أسوأ المخالفين في المنظومة التجارية العالمية".وحث ترامب اليوم الشركات على بدء الانتقال فورا إلى الولايات المتحدة لتنجب الخضوع للتعريفات الجمركية، بعد ساعات من دخول رسوم جديدة فرضها حيز التنفيذ.وكتب الرئيس الأميركي عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "هذا وقت رائع لنقل شركتكم إلى الولايات المتحدة الأميركية، مثل آبل، وكما تفعل (شركات) أخرى بأعداد قياسية، متعهدا بأن يكون ذلك مع "صفر تعرفات… ومن دون تأخيرات بيئية"، وتابع "لا تنتظروا، قوموا بذلك الآن".

يفاجئك الشاعر والصحفي السوري بشير البكر في كتابه الجديد، أن تكتب سردا بعين الشعر. يتحدث الراوي بلغة الشاعر، والحياة من الدفة إلى الدفة الأخرى تشبه حلما عمره نحو 50 عاما أو أكثر.كتاب "بلاد لا تشبه الأحلام" – الصادر مؤخرا عن دار نوفل/هاشيت أنطوان في بيروت- ليس رواية بالمعنى الكلاسيكي، ولا سيرة ذاتية مكتملة، بل نصّ يمزج السيرة والتأمل السياسي والمعرفي واللغة الشعرية. إنه سرد مشظّى، يكتبه صاحبه بضمير المتكلم، إذ يظلّ يتنقل بين المدن والمنفى، بين الحسكة وبيروت وبراغ وعواصم الغرب وأساطير الجزيرة السورية، ومنها إلى فضاء وجودي تتنازعه الأسئلة الحارقة: من نحن؟ وأين صرنا؟ ولماذا لا نعود؟يقدم كتاب "بلاد لا تشبه الأحلام" تجربة فريدة تتحدى التصنيفات الأدبية الجاهزة. فبصوت الراوي المتماهي مع الكاتب، ننخرط في رحلة شخصية عبر محطات حقيقية، من الحسكة إلى بيروت وبراغ ثم قبرص وباريس وسواحل الخليج العربي، لكن هذا البعد السيري يتداخل ببراعة مع تقنيات روائية، ليطرح سؤالًا جوهريًا عن طبيعة النص: هل هو سيرة ذاتية متخفية، أم عمل إبداعي حر يتجاوز القيود؟ ينجح البكر في خلق مساحة رمادية آسرة، حيث تتلاشى الحدود بين الواقعي والمتخيل، ربما لأن تجربة المنفى والذاكرة نفسها تتسم بهذا التشظي وعدم اليقين.هذا الغموض يُعززه البناء الشذري للكتاب، حيث تتناثر المقاطع وتتنقل بين الأمكنة والأزمنة والتأملات دون تسلسل خطي تقليدي. هذا الخيار الجمالي يبدو متوافقًا مع طبيعة الذاكرة الانتقائية والمتقلبة، ومع تجربة المنفى التي غالبًا ما تتميز بالانقطاع والتشظي. هل كان هذا التقطيع قرارًا فنيًا واعيًا، أم أنه انعكاس لتشظي التجربة نفسها؟ ربما كان كلا الأمرين صحيحًا، فالشكل الشذري يمنح الكاتب حرية التنقل بين اللحظات الحاسمة والتأملات العميقة، ويخلق لدى القارئ إحساسًا بالبحث والتنقيب في ثنايا الذاكرة.تتجلى في هذا الكتاب رعوية سحرية فريدة، حيث الطبيعة ليست مجرد خلفية بل كائن حي يتنفس ويتكلم. الجبال تتحول إلى أشقاء، والذئاب إلى كائنات متجولة بين التوحش والإنسانية، والأمكنة إلى أرواح تصاحب البطل في ترحاله. هذه الرعوية ليست نوستالجيا بل إعادة تخليق للمكان بوصفه حكاية متحولة، يُكتب فيها الجغرافي بوصفه شعريًّا، وتُصبح الأرض لغة، والبرية مأوىً رمزيًا يعوّض غياب الوطن.منذ افتتاحية الكتاب التي تبدأ بخرافة الأشقاء الثلاثة الذين تحولوا إلى جبال، يستخدم البكر رمزية مدهشة تضع الجغرافيا في قلب الصراع الإنساني، ويُخرج الخرافة من دائرة التراث الجامد لتصبح مفتاحًا لفهم الانقسام والخذلان والسكوت العربي. ثم تتوالى فصول الكتاب بوصفها مقاطع شعرية وسردية مملوءة بالحنين والقسوة: الذئب الذي أُعدم في دمشق، دفتر العائلة الضائع، شيلان الكردية التي لم تكتمل رحلتها، بيروت التي تأكل ذاتها، والموت الثالث الذي لا عودة منه.تبرز لحظات تاريخية مفصلية في ثنايا هذا السرد المتناثر، ولعل مشهد "عودة الأخ الضائع" يمثل ذروة مؤلمة. فبوصف قاس لعائد من حرب حزيران، يكشف البكر عن هشاشة الجيش السوري والتراخي المتواطئ الذي سبق سقوط الجولان. هذا المشهد، الذي يجعل الهزيمة تبدو قدرًا محتومًا، يثير تساؤلات عميقة عن طبيعة الهزيمة: هل كانت عسكرية فحسب، أم أنها حملت في طياتها هزيمة أخلاقية أعمق؟ بعد مرور سنوات طويلة، يظل هذا الفصل بمنزلة الجرح الأول في ذاكرة المنفى السوري، ويثير لدى القارئ تساؤلات عن الثمن الباهظ الذي دفعته سوريا في سبيل وصول حافظ الأسد إلى السلطة، وهو تلميح يتردد صداه بين سطور الكتاب.تمتد رؤية البكر النقدية لتشمل مناطق سورية أخرى، ففي فصل "عيسى والشيخ مسلط"، يرسم صورة قاتمة للجزيرة السورية، منطقة تعاني من التهميش والصراعات الداخلية والاستغلال. هذه الصورة المأساوية تدفعنا للتساؤل عما إذا كانت هذه هي النهاية المنطقية لمسار طويل من الإهمال، أم أنها شكل جديد من الاستعمار يتستر بشعارات زائفة. وفي هذا السياق، يطرح الكتاب سؤالًا حول دور الروحانية القديمة، التي يمثلها الشيخ الصوفي، في مواجهة هذا الواقع المتفجر.يُضيء الكتاب أيضًا على تجربة المنفى من زاوية إنسانية عميقة، ففي الفصل الذي يسبق "عيسى والشيخ مسلط"، يصبح فقدان "دفتر العائلة" رمزًا لفقدان الهوية والانتماء. في عالم المنفى، تصبح الوثائق الرسمية بديلًا هشًا عن الشعور الحقيقي بالوطن، ويتحول دفتر العائلة من مجرد ورقة ثبوتية إلى رمز للذات المفقودة أو المقيدة.يتناول البكر في فصل "من أجل حفنة من الدولارات" موضوعًا بالغ الأهمية وهو العلاقة المعقدة بين السلطة السورية والبنية العشائرية. يرصد الكتاب كيف استغل النظام هذه البنية التقليدية لإدارة الحكم وتوزيع الموارد، وكيف صعد أبناء شيوخ العشائر إلى مراتب النفوذ من خلال علاقاتهم بالمؤسسة الأمنية. يثير هذا الفصل تساؤلات حول الدور الذي لعبته البنية العشائرية في تكييف السلطة مع الهامش بدلًا من مواجهته، وما إذا كان هذا التحالف بين القبيلة والسلطة أحد أوجه تثبيت الاستبداد في سوريا. اليوم، تظل هذه العلاقة بين التركيبة العشائرية وآليات السلطة قائمة، ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان النظام قد أعاد هندسة البنية الاجتماعية عمدًا لضمان استمراره، أم أنه ببساطة استثمر هشاشتها.في مقاطع أخرى، يرصد الكتاب تحولًا رمزيًا عميقًا في مكانة القبيلة، فمن كيان يملك القوة ويحمي أفراده، تتحول إلى كيان منزوع السلاح والهيبة بعد صعود الدولة القومية. يصبح الحذاء الفاخر أكثر قيمة من البندقية، وهو تعبير رمزي عن تآكل قيم الرجولة والكرامة المرتبطة بالسلاح في مجتمعات تقليدية. يدفعنا هذا التحول للتساؤل عما إذا كان هذا التعرّي الرمزي للقبيلة إستراتيجية متعمدة لخلق مجتمع بلا حواضن تقليدية، وكيف يمكن قراءة هذا التآكل في سياق المجتمعات المعاصرة.يُظهر البكر براعة في الربط بين عوالم مختلفة، ففي فصل "قصاص الأثر"، يقيم توازيًا خفيًا بين تتبع الأثر في الصحراء وتتبعه في الكتب والأفكار. من خلال شخصية أخيه فرحان، الذي كان قصاص أثر للكلمات والمعاني، يقترح الكتاب نوعًا آخر من البداوة الفكرية التي تتجاوز حدود المكان المادي.يتأمل الكتاب أيضًا في مفهوم الموت، ففي فصل "الموت الثالث"، لا يُنظر إلى الفناء كونه نهاية بيولوجية فحسب، بل كتجربة وجودية يصعب الإمساك بها. يطرح البكر سؤالًا عن هذا الحد الأبيض الفاصل بين الحياة والمحو، ويتساءل عما إذا كانت الكتابة، بهذا المعنى، هي شكل من أشكال النجاة من هذا الموت الثالث، أم مجرد محاولة لتأجيله.يغوص الكتاب في عوالم حسية غنية في فصل "سامية، رائحة زهر الليمون"، حيث تحضر الروائح والأصوات والمشاعر بقوة. تظهر شخصية سامية كرمز للوطن المفقود أو الجمال الذي يُفتقد دائمًا، مما يثير تساؤلات عن ما إذا كان هذا الفصل وداعًا شخصيًا لعالم لم يعد موجودًا، وما إذا كانت سامية تمثل امرأة بعينها أم رمزية أوسع لحالة وجودية معلقة بين العشق والمنفى.يختتم البكر كتابه بفصل مؤثر بعنوان "نقطة على السطر"، حيث يتردد نداء بدوي في فضاء فارغ يشبه الصحراء بعد العاصفة. لا يظهر في الختام بطل أو حكاية مكتملة، بل حفيف الريح وسلك البرق المقطوع، تاركًا القارئ مع إحساس بالصمت والانتظار، وثمة سؤال يرن في وجدان القارئ: هل أراد البكر بهذا الختام تأبينًا شعريًا لفكرة الوطن، أم مرثية للذات التائهة في المنفى؟ وهل يعكس هذا الصمت اعترافًا بعدم جدوى الكلمات، أم انتظارًا لرسالة لم تصل بعد؟يمكن القول إن كتاب "بلاد لا تشبه الأحلام" ليس مجرد سيرة ذاتية أو رواية، بل هو عمل أدبي نقدي مشوق يجمع بينهما ليقدم رؤية عميقة ومتشظية للذاكرة والمنفى السوري. من خلال أسلوبه الشذري ولغته الشاعرية، يدعو بشير البكر القارئ إلى رحلة تأمل في التاريخ والسياسة والمجتمع، وإلى مساءلة الذات والهوية في عالم مضطرب ومتغير. إنه كتاب يترك أثرًا عميقًا في النفس، ويدفع إلى التفكير مليًا في معنى الوطن والمنفى والذاكرة.ما يميز هذا العمل أيضًا هو اشتغاله العميق على الرمز: السلاح، الحذاء، البرق، دفتر العائلة، الجبال، الذئب… كلها رموز تتكرر وتتحول وتتقاطع مع شخصيات واقعية أو مستدعاة، لتصنع عالمًا رمزيًا كاملًا بلا حاجة إلى حبكة تقليدية. كما أن حضور الشخصيات الهامشية – من شيلان إلى سامية، ومن فرحان إلى الشيخ مسلط – يضفي على النص بعدًا إنسانيًا كثيفًا، حيث لا وجود لأبطال، بل لشهود، ووجوه، وأصوات ضائعة في العراء.وفي خلفية كل فصل، تتكرر الأسئلة الجوهرية التي يطرحها النص على القارئ: هل لا تزال الكتابة ممكنة بعد كل هذا الانكسار؟ وهل المنفى خلاص أم محو؟ وهل يمكن لبدويّ أن يحمل ذاكرة الكتب بدل أثر الأقدام؟"بلاد لا تشبه الأحلام" هو كتاب مكتوب من الداخل، لا يطلب إعجابًا بل إصغاءً. وهو واحد من أبرز النصوص السورية المعاصرة التي تجاوزت رثاء الوطن إلى تفكيك معناه، وتجاوزت الحنين إلى تشريح جذوره. نصّ يستحق أن يُقرأ أكثر من مرة، لا بحثًا عن قصة، بل استعادةً لما ضاع من صوتنا ونحن نركض خلف الحدود.في "بلاد لا تشبه الأحلام"، لا يقدّم بشير البكر سيرة ذاتية بقدر ما يشهر وجعه الشخصي على هيئة مرآة للخراب العام. إنها ليست مذكرات شاعر أو صحفي فقط، بل هي سيرة وطن، وسردية جيل، وبيان عن حطام الأفكار.اللغة هنا ليست زينة أو سلعة، بل لغم مضمر. تأتي الجمل مثل قذائف مرتّبة بعناية، فتمضي بك من دفء الطفولة إلى برد المنافي، من ظلال الزيتون إلى صقيع الشمال. يتنقّل الكاتب في المكان، لكنه في الجوهر لا يبرح خيمته الأولى: خيمة السؤال. مَن نحن؟ كيف تحوّلنا من أبناء الحلم القومي الكبير إلى حُطام على أرصفة أوروبا؟لا يكتب البكر بلغة الاستعراض، بل بلغة الانكشاف. يجيد الإصغاء لذاكرته الشخصية كما يصغي المؤرّخ إلى وقع الحدث، لكنه لا يركن إلى الوثيقة الجامدة، بل يُشعل فيها نار الحكي. هكذا، تتحول التجربة إلى نصٍّ حي، تشتبك فيه التفاصيل الصغيرة مع أسئلة التاريخ الكبرى.سيرة البكر لا تقتصر على الأماكن التي أقام فيها، بل تشمل الأماكن التي قاوم فيها فكرًا، أو جادل فيها صديقًا، أو خسر فيها وطنا. الحسكة ليست مجرد مدينة للولادة، بل نصّ أوليّ للحب والسياسة معًا. دمشق ليست عاصمة، بل مشهد سقوط مدوٍّ. باريس ليست منفى فقط، بل مختبر روحي لرجل يدوّن شهادته قبل أن يتبخر الزمن.ثمة حزن ناعم يسري في الكتاب، لكنه ليس الحزن الذي يُبكِي، بل الحزن الذي يُفكِّر. كأن الكاتب يجرّ قارئه إلى الحافة كي يريه المشهد من أعلى، ثم يهمس له: "انظر جيدًا.. هذا ما فعلته بنا الأحلام حين لم نحسن حمايتها".لا يقدّم البكر بطلًا روائيًا ولا سردًا انتصاريًا. بطله الوحيد هو الوعي، وسرده سرد خاسر، لكنه لا يخجل من الخسارة. إنه يكتب عن زمن تآكل، وتآكل معه الحلم، واللغة، والمدينة.يذكّرنا هذا الكتاب أن السيرة، إذا كُتبت بصدق، تصبح عملاً فكريًا، لا مجرد رصف للذكريات. وأن الحنين، حين يصفّي نفسه من السموم، يتحول إلى نقدٍ مرّ، لكنه ضروري. تمامًا كما تفعل القهوة: تسقيك مرارتها، لكنها توقظك.

يعتقد الخبير العسكري العميد إلياس حنا أن العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية تستهدف تحقيق هدف أكبر وهو تدمير مثلث المخيمات وتغيير المنطقة جغرافيا وسكانيا لإنهاء فكرة المقاومة.ووفقا لما قاله حنا في تحليل للجزيرة -بشأن العملية العسكرية في الضفة- فإن حجم القوة المستعملة في مخيمات الضفة يكشف أنها أكثر من مجرد عملية عسكرية بسيطة رغم أنها لا تصل إلى وصف الحرب.لكن عمليات التدمير وطرد السكان التي يمارسها الاحتلال في هذه المخيمات، يكشف -برأي حنا- وجود خطة لتغيير المنطقة هندسيا وسكانيا، وجعلها مفتوحة أمام آليات الاحتلال في أي وقت.ويدخل هذا العمل -وفق الخبير العسكري- ضمن خطط إسرائيل لتدمير ما تعتبره ملاذا آمنا للمقاومة في شمال الضفة، وذلك بعد تدمير قطاع غزة.وتحاول إسرائيل من خلال هذه السيطرة قطع طرق تهريب السلاح من الأردن إلى شمال الضفة، وهو نفسه ما تقوم به على الحدود مع سوريا، كما يقول حنا.وفي وقت سابق اليوم، بدأ الاحتلال عملية واسعة في مخيم بلاطة وقام بالسيطرة على عدد من المنازل وتحويلها لثكنات عسكرية، فضلا عن توسيع الشوارع.واقتحمت قوات الاحتلال المخيم وأجبرت فلسطينيين على إخلاء منازلهم بالقوة، واعتقلت 5 أشخاص بينهم والدة شهيد خلال الاقتحام.وأفادت مصادر للجزيرة بأن أكثر من 300 آلية عسكرية حاصرت مداخل المخيم فجر اليوم تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجوائه.وقال الصحفي أنس موسى، إن قوات الاحتلال حولت عشرات المنازل لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميدانية مع الشبان الفلسطينيين، مؤكدا وضع مزيد من الحواجز الأمنية في مختلف مناطق نابلس.وواصلت قوات الاحتلال تفجير منازل في مخيم جنين، حسب موسى الذي تحدث عن تظاهر بعض النساء في طولكرم للمطالبة بالعودة إلى منازلهن التي تركنها بالقوة.ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية الواسعة التي بدأها في مخيمات شمال الضفة منذ نحو 3 أشهر، وهي عملية قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنها قد تمتد حتى نهاية العام.وتأتي هذه العملية ضمن خطة حكومة الاحتلال بتصفية المخيمات وتوسيع الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، كما قال موسى، مرجحا أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من هدم منازل مخيم بلاطة الذي يؤوي 25 ألف فلسطيني، على غرار ما حدث في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

هو رائد الإصلاح الشيخ محمد رشيد رضا الذي سلطت حلقة (2025/4/9) من برنامج "ّموازين" الضوء على حياته وعلى مشروعه الفكري والإصلاحي، الذي لم يقتصر تأثيره على العالم العربي بل امتد إلى دول إسلامية أخرى.ولد الشيخ رضا في قرية القلمون عام 1865، وهي قرية تقع على شاطئ البحر المتوسط من جبل لبنان. وينتمي إلى أسرة شريفة يتصل نسبها بالحسين بن علي رضي الله عنه. وكان أبوه علي رضا شيخا للقلمون وإماما لمسجدها، فعني بتربية ولده وتعليمه فحفظ القرآن، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب ونبغ في صباه.وبعد مرحلة التكوين في لبنان رحل الشيخ رضا إلى القاهرة، حيث رأى أن مصر ميدانا فسيحا للإصلاح والعمل مع شيخه الإمام محمد عبده، الذي بقي بصحبته 7 سنين.احتدمت في عصره المعارك الفكرية بين تيارين، تيار يقاوم الدعوة إلى التجديد والإصلاح، وآخر يدعو إلى تجاوز التعليم الديني واللحاق بالحداثة الغربية، فاتخذ الشيخ رضا صحيفة المنار منبرا لمقاومة التيارين وبيان الخلل الذي يكتنفهما.وحول مساره الفكري، يقول أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قطر الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك إن التقاء الشيخ رضا بالشيخ حسين الجسر الذي كان يعتبر من علماء تلك الفترة الأجلاء أعطاه مساحة أن يفكر في الجانب الذي يختص بعلاقة العلوم الدينية أو الإسلامية بالعلوم الدنيوية أو العلوم التي أتت إلى المشرق من الغرب الأوروبي.وجمع الشيخ رضا بين الجانب الفقهي والجانب الصوفي، وانتقل من تزكية النفس إلى القضايا المرتبطة بالجانب الشرعي وبالتشريع السياسي، الذي يرتبط بالشيخين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، كما يوضح أبو شوك.ويشير أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة لوفان الدكتور عمر رياض إلى أن الشيخ رضا ذهب إلى مصر والتقى الشيخ محمد عبده في منطقة عين شمس في القاهرة، وتحدث معه عن فكرة الإصلاح وفكرة إنشاء مجلة، وكتب أول عدد من مجلة المنار في المسجد المجاور لمنزل الشيخ محمد عبده.ويقول أبو شوك إن مصر كانت حاضنة لعدد من المجلات، لكن الشيخ رضا كان يرى أن هناك فراغا يجب أن يملأ، لأن المجلات الموجودة في مصر كلها ذات توجهات علمانية، ومعظم المحررين لا ينتمون للفكر الإصلاحي الإسلامي، فكان يعتقد أن مجلة المنار يمكن أن تسد هذا الفراغ.وكان الشيخ محمد عبده -يضيف نفس المتحدث- حريصا على ألا تدخل المنار في مجال السياسة، لذلك مالت الأعداد الأولى منها إلى قضايا محاربة البدع والخرافات والعودة إلى العقيدة التوحيدية، إضافة إلى قضايا وحدة الأمة والتعليم، لكن بعد وفاة الشيخ محمد عبده أخذت المنار منحا آخر ومالت للحديث عن السياسة وعن تأثير الاستعمار وقضايا الخلافة لاحقا.ويذكر أن العدد الأول من مجلة المنار صدر عام 1898، واستمرت إلى سنة 1935، وجرى جمعها في 33 مجلدا، وضمت 160 ألف صفحة. وقد حرص الشيخ رضا على تأكيد هدفه من المنار، وهو "الإصلاح الديني والاجتماعي للأمة وبيان أن الإسلام يتفق والعقل والعلم ومصالح البشر وإبطال الشبهات الواردة على الإسلام".وعن ملامح المشروع الفكري للشيخ رضا، يلفت الدكتور رياض إلى أن الراحل كان مشغولا بفكرة انحطاط العالم الإسلامي، وكان يرى مثل ما كان الشيخان جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده يريان أن انحطاط العالم الإسلامي يتلخص في 3 محاور: الاستعمار، فساد الحكام، وجمود العلماء، وكان يحارب على هذه الجبهات. كما أن المشروع الفكري للشيخ رضا لم ينطبق على مصر أو العالم العربي، بل كان يمتد للعالم الإسلامي، مثل إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا.وعن مدى امتداد الحركة الإسلامية المعاصرة اليوم للمشروع الفكري للشيخ رضا، يؤكد الدكتور رياض أنه لا يوجد أي ذكر في مجلة المنار لحسن البنا ولا لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه يكشف أن والد حسن البنا، الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي نشر مسند الإمام أحمد في مطبعة المنار، وهناك مراسلات في الأرشيف بين الشيخ رضا ووالد البنا.ويضيف أن الشيخ رضا حينما ذهب إلى مصر جاب القرى لتكوين نواة لحركة إسلامية إقليمية في مصر، وأن "حسن البنا قد أخذ بعض هذه الأفكار وهذه التفاعلات والتحركات ووضع بها نواة الإخوان المسلمين".

يُطلِق عليها البعض "الحرب اللانهائية"، وتُعد أحد أكثر النزاعات دموية وبشاعة في القارة الأفريقية، إذ تسجل حتى الآن عددا ضخما من الخسائر البشرية. في نظر آخرين، ليست هذه الحرب مجرد صراع دموي، بل زلزال جيوسياسي قد يُعيد تشكيل خارطة شرق القارة السمراء. إنها حرب مفتوحة، ومتشابكة، وتتسع رقعتها باطراد، ويخوضها أكثر من مئة جماعة مسلحة، فيما تزداد تعقيداتها مع دخول جيوش نظامية على خط المواجهة.حرب الكونغو، مشهدها المتشابك يجعل من الصعب تصنيفها حربا أهلية، خاصة بعد أن تداخلت فيها مصالح قوى إقليمية ودولية، وتحولت إلى ساحة تتقاطع فيها الأجندات وتتصادم المصالح. فما الجذور العميقة لهذه الأزمة؟ هل وُلدت اليوم أم أن لها امتدادا تاريخيا شكَّل ملامحها الراهنة؟ وكيف يبرر كل طرف في هذا الصراع موقفه ويُصنِّف خصمه؟ في هذا التقرير، نحاول البحث عن إجابات لهذه التساؤلات، متحررين من السرديات الأحادية، ومنفتحين على زوايا تحليل متعددة، في محاولة لفهم أعمق لهذا الصراع المتجذر في قلب أفريقيا.لم تكن أفريقيا، القارة السمراء، أرضا بكرا موحشة قبل أن يصلها المستعمر الأوروبي، كما سعت السرديات الاستعمارية لترويج ذلك، بل كانت قارة نابضة بالحياة، غنية بثقافاتها وممالكها التي تنوعت أنشطتها الاقتصادية بين الزراعة والصيد والتجارة والحِرَف المحلية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي جعلها حلقة وصل بين أفريقيا وآسيا.ازدهرت الممالك الأفريقية بنظمها الزراعية، واعتمد بعضها على نظام المشاعية في تقسيم العوائد، حيث كانت الثروات تُوزَّع بين الأسر بشكل منظم وتحت إدارات محلية متماسكة نسبيا. ولكن مع وصول الأوروبيين في القرن السادس عشر، بدأت موجة من التغيُّرات قلبت النظام الاجتماعي في القارة. فالقادم من أوروبا، الذي خرج للتو من ظلمات الإقطاع متجها نحو الرأسمالية، لم يرَ في الأفريقي سوى آلة يمكن تسخيرها لاستخراج الثروات.كانت البرتغال أولى القوى التي استباحت السواحل الأفريقية، حيث استعبدت سكانها وسخَّرتهم للعمل في مزارع الجزر الأطلسية والبرازيل. في البداية، لجأ البرتغاليون إلى الغارات المسلحة، لكنهم واجهوا مقاومة شرسة، كما حدث عام 1444 حين حاولوا غزو السنغال، حتى فوجئوا بمقاتلين محليين متمكّنين من أساليب القتال التقليدية. دفعهم ذلك إلى تغيير استراتيجيتهم، فانتقلوا من الغزو إلى بناء تحالفات مع ملوك أفارقة ممن باعوا الأسرى والذهب مقابل السلع الأوروبية. ورغم المقاومة التي أبداها بعض الملوك الأفارقة، فإن وجود وسطاء وخونة سهَّل استمرار هذه التجارة، حتى تحوَّلت القارة إلى مسرح لصراعات دموية غذَّتها التحالفات الأوروبية.وقد عمد المستعمِرون إلى إشعال الحروب بين القبائل، ليصبح الأسرى وقودا لتجارة الرق التي نهشت المجتمعات الأفريقية. وكانت الكونغو وغرب أفريقيا أكثر المناطق تضرُّرا، حيث فقدت نسبة من سكانها تُقدَّر بعُشر إلى ثُلث السكان، وتراجعت أنشطتها الاقتصادية من الزراعة والصيد، في حين تكيَّف بعضها بالاندماج في الشبكات الرأسمالية الجديدة، ومن ثمَّ صار سكان القارة سجناء في دوامة من العبودية والمقاومة. وهكذا، لم يكن وصول الأوروبيين إلى القارة مجرد لقاء حضاري، بل لحظة فاصلة دشَّنت حقبة طويلة من الاستغلال والاستعمار.حين جاء التاجر الأوروبي وروَّج سلعته على حساب الإنسان الأفريقي، كثيرا ما حدث ذلك باسم الدين. ففي عام 1455، أصدر البابا مرسوما اعتبر غير المسيحيين كفارا ينبغي إذلالهم واسترقاقهم، وادّعت الكنيسة أنها تسعى لتنوير الشعوب وتحريرهم، لكنها كانت الأداة الأولى في ترسيخها، إذ أنشأت المدارس والمستشفيات في الأراضي المُستعمَرة. كانت المدارس تُدرِّس الثقافة الأوروبية للشباب المحليين لاستمالتهم، فيما اعتمد المبشرون والأطباء على الترويج للعقيدة المسيحية جنبا إلى جنب مع تقديم المساعدة الطبية.لكن الكنيسة لم تكتفِ بذلك، بل زرعت الخضوع في نفوس السكان، وأضفت الشرعية على الفقر والحرمان، وعزَّزت التفرقة بين الجماعات الأفريقية، مما عمَّق الصراعات القبلية. لعبت مدارسها دورا في تكريس سردية المستعمِر حول الأصول المتمايزة للقبائل، فكانت العقيدة والدين أداتين لإعادة تشكيل المجتمعات الأفريقية بما يخدم السلطة الاستعمارية.حمل الألمان إلى شرق القارة خرافة "العِرق الحامي"، وهو تسلسل عنصري يضع التوتسي مباشرة بعد العِرق الأبيض. قبل وصول الأوروبيين، كانت الممالك الأفريقية تجمع مختلف العشائر في وحدة اجتماعية واقتصادية متماسكة. لكنّ الألمان والبلجيكيين كرَّسوا هوية التوتسي والهوتو، وأجروا تجارب عنصرية لإثبات نظريتهم. فقد قام ريتشارد كانت مع باحثين ألمان بسرقة جماجم من رواندا لإجراء قياسات عليها، كما صبُّوا الجبس على وجوه السكان لصنع مجسمات تُستخدم لتحديد الفروق العِرقية المزعومة.عندما أجرى البلجيكيون لاحقا تعدادا سكانيا، لم يكن المعيار إثنيا، بل اقتصادي: مَن يملك أكثر من عشر بقرات وله أنف طويل صار "توتسي"، ومَن يملك أقل من ذلك صار "هوتو". قد يبدو هذا التصنيف اعتباطيا، لكن تأثيره كان مدمرا. لقد زرعت الكنيسة والمدارس الأوروبية فكرة التفوُّق العِرقي، حتى باتت المجتمعات المحلية تصدقها. فقد سعى المستعمِر، بكل أدواته، إلى محو تكريس تصورات هوياتية تخدم مصالحه، فكلما ضعف النسيج الاجتماعي، سهلت السيطرة على الموارد.قبل مائة وأربعين عامًا، في مؤتمر برلين عام 1884، قُسِّمت أفريقيا بين القوى الاستعمارية الأوروبية، مما أدى إلى تمزق الممالك الأفريقية، بما في ذلك رواندا، والكونغو، وأوغندا، حيث بدأ البلجيكيون في فرض سياسات تمييزية من خلال تحديد "الهوية العِرقية" في الوثائق الرسمية، وتعزيز سلطة التوتسي على حساب الهوتو. وحين حصلت الكونغو على استقلالها، ورثت هذه الشروخ الاجتماعية، مما فاقم الصراعات العِرقية. وفي عام 1981، أصدر موبوتو سيسي سيكو في الكونغو قوانين تقيِّد الجنسية على أساس الانتماء الإثني، مما عمَّق الانقسامات داخل المجتمع، وأعاد إنتاج الصراعات العِرقية التي زرعها الاستعمار الأوروبي قبل قرن."الإبادة الجماعية ليست شيئا يحدث فجأة، إنها جريمة كراهية يُحضَّر لها، وتُبنى ظروف تسمح بوقوعها. إنها ليست فعل أفراد، بل جريمة ترتكبها دول وحكومات".-المؤرخ الرواندي توم نداهيروبدأت كراهية التوتسي قبل عام 1994، وكان للاستعمار البلجيكي دور حاسم في خلق أزمة هوية حقيقية في وسط أفريقيا. فقد عمل علماء الأنثروبولوجيا البلجيكيون على صياغة نظريات حول أصول سكان رواندا، مدّعين أن التوتسي هاجروا من الشمال وأنهم ليسوا سكانا أصليين. وبهذا، تركت بلجيكا عند استقلال رواندا إرثا من الانقسامات العِرقية العميقة التي مهّدت للتوترات العِرقية والإبادة الجماعية لاحقا. ويقول الباحث السياسي الرواندي غاتيتي نييرينغابو في مقابلة مع الجزيرة: "كرَّست بلجيكا مصالح أقلية أرستقراطية من أثرياء التوتسي، وتركت البقية يغرقون في فقر مدقع، بصرف النظر عن إثنيتهم، وأدى ذلك، منذ عام 1957، إلى أولى موجات العنف ضد التوتسي، بحجة سيطرتهم على مقدرات البلاد وإقصاء الهوتو".ووفقا للمؤرخ نداهيرو، فقد أُصدِر "بيان باهوتو"، الذي دعا إلى "انتزاع حق الهوتو في البقاء والوجود وتجريد التوتسي من صلاحيات الحكم"، وصيغ البيان بتحريض من سلطات الاستعمار، وبدعم من رجال الدين الكاثوليك، الذين تحوَّلوا إلى دعاة كراهية، مما أدى إلى تأسيس حركة "بارميهوتو" أو "انعتاق الهوتو". هذه الحركة، التي وصفها المؤرخون بأنها أقرب إلى ميليشيا منها إلى حزب سياسي، كانت أحد المحركات الرئيسية للعنف العِرقي في رواندا.في ظل هذا التوتر العِرقي، اندلعت الحرب الأهلية في رواندا بين القوات المسلحة الرواندية، التي كانت تهيمن عليها أغلبية الهوتو، وبين الجبهة الوطنية الرواندية، وهي حركة تمرد بقيادة التوتسي. لقد بدأت الأزمة منذ نهاية الخمسينيات، وأطاحت بالنظام الملكي التوتسي وأقامت جمهورية بقيادة الهوتو، مما دفع أكثر من 336 ألف من التوتسي إلى الفرار نحو البلدان المجاورة. وفي أوغندا، شكَّل اللاجئون التوتسيون الجبهة الوطنية الرواندية بقيادة فريد رويجيما وبول كاجامي، وتحولت الجبهة في أواخر الثمانينيات إلى قوة عسكرية منظمة. واستمر القتال رغم اتفاقيات السلام، ومع مرور الوقت، بدأ المتطرفون من الهوتو في التخطيط لإبادة التوتسي بشكل منهجي.بين عامَيْ 1990-1994، عززت جماعات الهوتو المتطرفة نفوذها في رواندا، وخططت لإبادة التوتسي. وبدأ التنفيذ الفعلي عقب اغتيال الرئيس جوفينال هابياريمانا، فاندلعت الإبادة الجماعية التي قُتل فيها أكثر من 800,000 شخص خلال 100 يوم، أي بمعدل 8,000 قتيل يوميا، مما جعلها واحدة من أبشع المجازر في التاريخ.هرب العديد من التوتسي إلى الكونغو، لكنهم لم يكونوا وحدهم، تبعهم أيضا المُتَّهمون بالمشاركة في الإبادة، مما جعل المنطقة بؤرة للعنف المستمر، في ظل غياب أي حلول جذرية من الحكومة الرواندية. وقد استمرت النزاعات العِرقية، وبقيت التنظيمات المتورطة في المجازر نشطة، مما جعل مستقبل المنطقة مفتوحا على مزيد من التصعيد والصراعات الدموية.في 31 أغسطس/آب 1996، اندلع ما عُرف بتمرد البانيامولينغ بقيادة تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو للإطاحة بالرئيس موبوتو سيسي سيكو، بدعم من رواندا وأوغندا وأنغولا وبوروندي. وبرَّرت رواندا تدخلها بأن الهوتو الفارين إلى شرق الكونغو ارتكبوا إبادة جديدة بحق التوتسي الكونغوليين، واستخدموا إقليم كيفو قاعدة لشن هجمات ضدها، بدعم مباشر من نظام موبوتو.كان عهد موبوتو المديد عهد انهيارات اقتصادية حادة: تضخم مفرط، وديون هائلة، وانخفاض متكرر في قيمة العملة. وعلى مدى ثلاثة عقود، صُنِّفت أوضاع حقوق الإنسان في بلاده من بين الأسوأ في العالم. وفي 1997، تمكَّن المتمردون من الإطاحة بموبوتو، ليصل لوران كابيلا إلى السلطة، وهو الذي سبق أن قاد عدة ثورات ضد نظام موبوتو.بعد وصوله إلى الحكم، لم يكن لوران كابيلا مختلفا كثيرا عن سلفه. فقد اتُّهم بأنه أصبح أقرب إلى دكتاتورية موبوتو، حيث أعدم آلاف المدنيين العُزّل ومئات الجنود من التوتسي، وضيَّق على الحريات العامة، وازداد تورُّطه في الفساد. كما بدأ في تهيئة ابنه جوزيف لتوريثه السلطة، مما أثار استياء حلفائه السابقين. انقسم التحالف الذي أوصل كابيلا إلى الحكم، وشكَّل التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية، الذي عُرف لاحقا باسم "ماي ماي"، وهو في الحقيقة ميليشيا. بالتوازي مع ذلك، توترت علاقات كابيلا مع رواندا وأوغندا، رغم أنهما كانتا من أكبر داعميه في الحرب الأولى، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية ثانية عام 1998، لكن ضده هذه المرة، وقادتها رواندا بدعم أميركي.على الجهة الأخرى، حصل كابيلا على دعم كلٍّ من أنغولا وتشاد وناميبيا وزيمبابوي، مما أدى إلى حرب متعددة الأطراف. ورغم تحالفه مع عدة دول، فإن قوات كابيلا تكبَّدت هزائم متكررة، أبرزها في معركة بويتو أواخر عام 2000، حيث خسرت الكونغو مئات الجنود. كادت قوات المتمردين أن تطيح بالحكومة نهائيا، لولا أن 3,000 عسكري كونغولي تمكنوا من الفرار إلى زامبيا، وسط موجات ضخمة من النازحين الذين هربوا من جحيم الحرب.تأسست حركة "إم 23" يوم 6 مايو/أيار 2012، وهي تتفرع عن حركة مسلحة أخرى تُعرف باسم "المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب"، وتدافع عن الإثنيات في منطقة كيفو الشمالية شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخاصة قبائل التوتسي. تعتبر الحركة نفسها مزيجا بين العمل السياسي والعسكري، وتهدف إلى معالجة الإخفاقات التي تعاني منها الحكومة الكونغولية، وبالأخص عدم تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في 23 مارس/آذار 2009.بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية، اندلعت مواجهات جديدة حين انفصلت مجموعة مسلحة كانت ضمن الجيش بموجب الاتفاقية، وقد كان معظم أفرادها من التوتسي، ليُطلق عليها اسم "إم 23". يرى مؤسسو الحركة أنفسهم حركة مقاومة ضد الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد مجتمعهم من الحكومة الكونغولية والجماعات المسلحة في المنطقة، وهم يُصرّون على أن حمل السلاح كان دفاعا عن النفس، وأن توسعهم في المنطقة كان نتيجة الحاجة إلى الحماية الأمنية، وعدم الالتزام بشروط اتفاقية إدماجهم في الجيش.تشير تقارير عدة من منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" إلى انتهاكات فظيعة في المنطقة، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب من قِبَل الجماعات المسلحة مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال القسري. على سبيل المثال، في 2010، قُتل نحو 96 مدنيا في بوسورونغي في إقليم واليكالي، بينما شهد إقليم لوبيرو الجنوبي حالات اغتصاب من قِبَل الجماعات المسلحة.أظهرت حركة "إم 23" استعدادا للتفاوض أثناء اتفاقية نيروبي الأولى لوقف إطلاق النار، حيث انسحبت من المناطق التي كانت قد سيطرت عليها. لكن القوات الكونغولية عادت إلى تلك المناطق، ما أدى إلى استئناف الصراع. في المقابل، رفضت الحكومة الكونغولية التفاوض مع الحركة واتهمتها بانتهاك الاتفاقية. في لقاء مع الجزيرة، اعتبر ممثل الحركة أن الصراع مع الحكومة الكونغولية هو صراع وجودي بالنسبة لقبائل التوتسي، مشيرا إلى أن جذور الصراع تاريخية، وأن الحكومة تستخدم خطاب الكراهية أداةً للحكم. كما أشار إلى أن قبائل التوتسي أصبحت كبش فداء للحكومة، التي تستخدمها لتشتيت انتباه الشعب عن فشلها في إدارة البلاد.تَعتبر حكومة كينشاسا أن الأزمة الأمنية في شرق البلاد انتهاك صارخ من الحكومة الرواندية لسيادتها، حيث اعتبرت التصعيد الأخير بمنزلة "احتلال" من القوات الرواندية. في تصريحات متتالية، وصف المسؤولون في الحكومة الكونغولية ما يحدث في شرق الكونغو بـ"العدوان" على أراضيها، حيث يتجاهلون وجود حركة "إم 23" ويمثلونها فقط بوصفها أداة تحركها القوات الرواندية. كان الرئيس الكونغولي قد صرح سابقا قائلا: "شرق البلاد يشهد تدهورا غير مسبوق في الوضع الأمني، قوات الدفاع الرواندية تدعم دميتها حركة "إم 23″ لتواصل أعمالها الإرهابية على أراضينا".من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الكونغولية، في لقاء صحفي أثناء اجتماعات مجلس الأمن الدولي، أن "ما يحدث ليس مجرد سيطرة لمتمردي حركة "إم 23″، بل هو احتلال من القوات الرواندية"، وأضافت أن تقريرا للأمم المتحدة قد أكد وجود 4000 جندي رواندي في شرق الكونغو. كما طالبت الكونغو في مجلس الأمن بانسحاب القوات الرواندية وفرض عقوبات على قياداتها، ما يُظهر بوضوح التباين الكبير بين رواية الحكومة الكونغولية ونظيرتها الرواندية.رغم وجود اتفاقية سلام ووقف إطلاق النار بين الطرفين، فإن الصراع ما زال يتفاقم، خصوصا في ظل تمسك الكونغو بعدم تحييد قوات "FDLR"، التي تعتبرها رواندا تهديدا بعد تورطها في عملية الإبادة الجماعية في 1994. كما رفض الرئيس فيلكس تشيسكيدي الحوار مع حركة "إم 23″، ما زاد تعقيد الوضع. وكانت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا فاغن قد بررت موقفها بعدم الحوار مع "إم 23" بأن عملية لواندا للسلام يجب أن تكون بين الدول لا الحركات المسلحة. وبخصوص موقف الكونغو من عملية لواندا، ادعت الوزيرة أن العملية هي المسار الوحيد للتفاوض، لكن رواندا انسحبت منها بسبب عدم التزام الأطراف باتفاقية السلام السابقة، بالإضافة إلى عدم حل قضية قوات "FDLR"، التي تشكل تهديدا للأمن الرواندي.تشير الإحصائيات إلى أن عدد الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تجاوز المئة. ومع تجدد الصراع، انضم بعض هذه الجماعات إلى الجيش الكونغولي النظامي، بينما تواصل أخرى القتال ضد القوات الحكومية أو تنفيذ عمليات عبر الحدود. من بين هذه الجماعات حركة "إم 23" و"تحالف الكونغو"، اللتان تخوضان مواجهات ضد الجيش الكونغولي، إلى جانب جماعات معارضة مسلحة لأوغندا، وكذلك حركات معارضة بروندية تشنّ هجمات على حدود بروندي انطلاقا من الأراضي الكونغولية. كما تضم "الحركة الديمقراطية لتحرير رواندا" أفرادا متورطين في الإبادة الجماعية بحق التوتسي، الذين فرّوا من العدالة في رواندا إلى الكونغو.يتألف تحالف "نهر الكونغو" وحركة "إم 23" من أعضاء ينتمون إلى مجموعة متنوعة من القبائل الكونغولية، من بينها قبيلة الهوتو من شمال كيفو، والهوند، والباشي، والتوتسي، بالإضافة إلى قبيلة البالوبا التي ينتمي إليها الرئيس الكونغولي نفسه. يشير هذا التكوين المتنوع إلى أن هذه الجماعات لا تمثل فقط أداة لخدمة المصالح الرواندية، بل تعكس أيضا تعقيد الوضع الداخلي في الكونغو الديمقراطية. ويدرك الرئيس تشيسكيدي هذا الواقع، مما يعكس عمق النزاع وأبعاده المحلية التي لا يمكن تجاهلها.تسعى الأمم المتحدة والإعلام الغربي إلى تصوير الصراع في منطقة شرق الكونغو بوصفه حربا على المعادن والثروات، حيث يُنظر إليه على أنه صراع بين أبناء المنطقة حول السيطرة على المناجم والموارد الطبيعية. تتهم هذه الأطراف رواندا بالتوسع الجائر في المنطقة، متجاهلة بذلك الرواية التي تقدّمها كلٌّ من حركة "إم 23" وحكومة رواندا، التي تعتبر أن هذا الطرح سطحي ولا يعكس الواقع، بل إنه غير قادر على تقديم حلول فعالة للمشكلة.في بيانها الأخير، الذي جاء تعليقا على تطورات الأحداث الأمنية في المنطقة، أعلنت مجموعة الدول السبع الكبرى (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي) دعمها لرواية الحكومة الكونغولية، مع إلقاء اللوم الكامل على حكومة رواندا، ودعت هذه الدول "إم 23" والقوات الرواندية إلى وقف عدوانهما على الأراضي الكونغولية والجلوس على طاولة الحوار.رغم اعتراف مجلس الأمن الدولي بتورط ميليشيات "FDLR" في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا، بالإضافة إلى تورطها في ارتكاب جرائم بحق بعض القبائل في شرق الكونغو، فإن الأمم المتحدة لم تعارض التعاون بين هذه الميليشيات والجيش الكونغولي، بل تجاهلت بوضوح الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين في المنطقة. هذه المواقف تجعل الأمم المتحدة عرضة للاتهامات بالتحيز وازدواجية المعايير، ويضاف إلى ذلك تورط بعض الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في جرائم متعددة بحق المدنيين في المناطق المتوترة، وفقا لتصريحات مسؤول سابق، مما يعزز من الشكوك حول مصداقية التحقيقات التي تُجريها هذه الهيئات.في الوقت نفسه، يزداد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، خصوصا مع العلاقات الاقتصادية القوية بين رواندا والصين. ويُشكِّل هذا التنافس تهديدا مباشرا للمصالح الغربية في المنطقة، لا سيما ممر "لوبيتو"، الذي بدأته الصين فعلا عبر شراكات مع ماليزيا. ولهذا السبب، انحازت الدول الغربية إلى الموقف الكونغولي، حمايةً لمصالحها الإستراتيجية والاقتصادية في المنطقة. يقع ممر لوبيتو في جنوب غرب القارة الأفريقية، وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، زار الرئيس الأميركي جو بايدن أنغولا، وأعلن عن مشروع كبير لتطوير شبكة السكك الحديدية لربط الكونغو وزامبيا وميناء لوبيتو في أنغولا. يهدف المشروع إلى تسهيل نقل المعادن الحيوية مثل النحاس والكوبالت من حزام النحاس في زامبيا والكونغو إلى الأسواق العالمية عبر الساحل الغربي لأفريقيا، لكنه يهدف أيضا إلى منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية.تواصل رواندا رفضها لادعاءات مجلس الأمن وحكومة الكونغو بشأن تدخلها العسكري في المنطقة، حيث تَعتبر أن الحكومة الكونغولية تتجاهل السبب الحقيقي وراء تجدد الصراع بعد عشرة أعوام، الذي يتمثل في التمييز العنصري الذي تمارسه الحكومة ضد سكان شرق الكونغو، وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية. وتُؤكد رواندا أن الموقف الدولي كان منحازا بشدة، ما زاد من تعقيد الأزمة بدلا من حلها. وتتهم رواندا الأمم المتحدة بالتقليل من تهديد منظمة "الحركة الديمقراطية لتحرير رواندا"، التي صُنِّفت جماعة إرهابية على خلفية تورطها في الإبادة الجماعية بحق التوتسي الكونغوليين. وتُشير إلى أن هذا التصنيف سمح للحكومة الكونغولية بالتعاون مع هذه المنظمة، ما أسهم في تطبيع العلاقات بين الطرفين.تنتقد رواندا تدخلات الأمم المتحدة من عدة أوجه. من الناحية الأمنية، ترى أن تدخل "مونوسكو" قد أسهم في تفاقم الوضع، حيث أصبح انتشار الميليشيات أكثر اتساعا، مما أصبح بمنزلة دعم غير مباشر للجيش الكونغولي، الذي يضم في تحالفاته الحركة الديمقراطية لتحرير رواندا ويجند مرتزقة أجانب، وهو ما يخالف القانون الدولي. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن تفعيل المادة 1502 من قانون دود-فرانك الأميركي، الذي يحظر شراء المعادن من الكونغو، أدى إلى انهيار اقتصادي في المجتمعات المحلية، وزيادة الاعتماد على المناجم التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة. كما سمح ذلك بإنشاء طرق جديدة لغسل المعادن عبر رواندا وأوغندا، مما يعقّد جهود مكافحة الفساد.دعت رواندا إلى حل سلمي وضرورة إرساء الحوار بين الأطراف المتنازعة، حيث أكدت أن مطالب حركة "إم 23" بسيطة وتتعلق بحقوق المواطنين الأساسية، وأن الحلول تكمن في الحوار وليس في التدخلات العسكرية أو السياسية. وفي تحول اقتصادي ملحوظ، أصبحت الصين الشريك الاقتصادي الأول لرواندا، حيث صرح الرئيس الرواندي بأن الصين لم تُملِ على رواندا سياساتها، في إشارة إلى السياسة الغربية التي تفرض توجهاتها على الدول الأفريقية. وفي المقابل، تراجعت العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث كان آخر اجتماع رسمي بين الجانبين عام 2019.كل هذه التحولات تجعل من رواندا عقبة أمام مصالح الغرب والولايات المتحدة في المنطقة، مما يجعلها دولة غير مرغوب فيها في الساحة الدولية، ولا سيما في إطار الأمم المتحدة.

يرى مراقبون أن العمليات العسكرية الأميركية في منطقة البحر الأحمر هدفها الرئيس مكافحة تهديدات جماعة أنصار الله (الحوثيين) وضمان استمرار حرية الملاحة، لكنها أيضا جزء من إستراتيجية واسعة تهدف إلى حماية الممرات البحرية الحيوية والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط.ويتمركز نحو 30 ألف جندي أميركي بشكل دائم في العشرات من القواعد العسكرية المنتشرة في أكثر من 15 دولة في المنطقة، فضلا عن أساطيل حربية موجودة بشكل دائم في المياه المحيطة بالمنطقة، إضافة إلى تعزيزات مؤقتة في الجند والعتاد ترسل في زمن التوتر والأزمات.وفي هذه المادة الشارحة، نحاول من خلال 4 نقاط رئيسة، تسليط الضوء على الوجود الأميركي في الشرق الأوسط والممرات البحرية الحيوية للملاحة الدولية وأماكن انتشار القوات الأميركية قربها.وفقا لمعاهدات وتفاهمات ثنائية، أو بناء على طلب من الدولة المضيفة، تنتشر القوات الأميركية في أكثر من 15 دولة في الشرق الأوسط، ويقدر عدد الجنود فيها بنحو 40 ألفا.وبينما تنشر الولايات المتحدة عددا ضئيلا من القوات في بعض الدول، وتسجل دول أخرى حضورا مكثفا، بما يزيد على 10 آلاف جندي، لا سيما في دول الخليج العربي.-قاعدة الإسكان الجوية: وهي مقر المجموعة الجوية 320 والمجموعة الاستطلاعية 64.-قاعدة الأمير سلطان الجوية: استقرت فيها القوات الأميركية عام 1990، وبقيت فيها 13 عاما، ثم انسحبت منها عام 2003. وفي مطلع عام 2020 عادت الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري بشكل ملحوظ في القاعدة، على إثر تصاعد التوتر مع إيران.-قاعدة الظفرة الجوية: وهي المقر الرئيسي للقوات الأميركية في الإمارات، ويوجد بها وحدة الانتشار الجوي الأميركي 380، وتقدم كذلك خدمات الدعم اللوجيستي وتزويد الطائرات بالوقود.-ميناء جبل علي: ويلقى إقبالا كثيفا من القوات البحرية الأميركية، ويضم رصيفا قادرا على خدمة حاملات الطائرات.–قاعدة العديد التي تعد أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وأكبر قاعدة جوية أميركية في الخارج.وتعتبر هذه القاعدة مقرا لكل من: القيادة العسكرية الأميركية الوسطى، والقيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، والمركز المشترك للعمليات الجوية والفضائية وجناح المشاة 379 للبعثات الجوية، والمجموعة 319 الاستكشافية.-قاعدة مصيرة الجوية وتستخدم لتسيير طائرات التجسس، وبها محطة مراقبة للمسطحات المائية في المنطقة.-قاعدة المسننة الجوية وتستخدم لعمليات النقل الجوي، وتضم مخازن أميركية ضخمة للذخيرة.-قاعدة الجفير البحرية وهي القاعدة البحرية الشاطئية الدائمة الوحيدة في الشرق الأوسط، وتوجد بها القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (سنتكوم)، ومقر الأسطول الخامس الأميركي.-قاعدة الشيخ عيسى الجوية: استُخدمت في الحرب على أفغانستان. ويوجد فيها مخيم للدعم الجوي.-قاعدة عريفجان: وتعد أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الكويت، وتمثل المقر الرئيس للقوات الأميركية في البلاد.-قاعدة علي السالم الجوية: وتضم فرقة من القوة الجوية الأميركية 386، التي تعد محورا للنقل الجوي وقوة دعم للقوات المشتركة وقوات التحالف الدولي في المنطقة.-قاعدة بلد الجوية: وهي أكبر القواعد بالعراق، ومقر مهم للقوات الأميركية، وتحتوي على منشآت عسكرية متعددة.–قاعدة عين الأسد الجوية: وتعد ثاني أكبر قاعدة بالعراق، وتتمركز فيها معظم القوات الأميركية، وتعتبر مركزا لانطلاق العمليات الخاصة.-ليس للجيش الأميركي قاعدة عسكرية قتالية في مصر، ولكن هناك نحو 600 عسكري ضمن القوة الدولية المتعددة الجنسيات، الموجودة في مصر منذ عام 1981 (بحسب مصادر رسمية أميركية عام 2022).-تقدم مصر تسهيلات للقوات البحرية الأميركية في الموانئ المصرية، وتسهيلات للقوات الجوية الأميركية في قاعدة غرب القاهرة الجوية.-يقع مقره في البحرين وتتركز منطقة نشاطه في المجال الممتد من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، مرورا بالمحيط الهندي وبحر العرب.-يعمل على تعزيز النفوذ الأميركي وحماية طرق التجارة والملاحة البحرية ومصادر الطاقة ومحاربة "الإرهاب" والقرصنة البحرية والتحديات السيبرانية.-يصل عدد أفراد الأسطول إلى نحو 15 ألف عنصر على السفن، إضافة إلى ألف عنصر على اليابسة.-يتكون في الظروف العادية من أكثر من 20 سفينة حربية، بما فيها غواصات ومدمرات.-أواخر الشهر الماضي، مدد وزير الدفاع بيت هيغسيث فترة عملياتها في الشرق الأوسط لشهر إضافي لدعم الضربات الموجهة للحوثيين.-تشمل مهام الحاملة عمليات الأمن البحري والاستجابة للأزمات والردع ومكافحة الإرهاب إضافة إلى التعاون الأمني.-لها القدرة على حمل حوالي 85 طائرة من طرازات مختلفة، ويديرها طاقم يتكون من حوالي 3200 و200 فرد في السفينة و2480 فردا في الجناح الجوي.-يمكنها استيعاب أكثر من 60 طائرة بفضل سطحها الواسع، وتشمل طائرات "إف إيه-18 سوبر هورنت" و"بوينغ إي إيه 18 جي غرولير".-أواخر الشهر الماضي، أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بإرسالها إلى الشرق الأوسط لدعم الضربات الموجهة للحوثيين.-توصف بمطار أميركا العائم وتعد ثالث حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية وأضخم السفن الحربية في العالم.-تتخذ من سان دييغو في كاليفورنيا مقرا لها ويتألف طاقمها من حوالي ألفي فرد في السفينة وألفي فرد في الجناح الجوي.-تحمل 9 أسراب طيران بحرية وتشغل عددا من المقاتلات أبرزها "إف-35".-يربط مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج عمان ومن بعده المحيط الهندي.-يمر عبره 11.1% من إجمالي التجارة البحرية العالمية.-يمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، وذلك ما يجعله من أهم نقاط الشحن في العالم.-يعدّ المضيق الممر الرئيس للنفط والغاز المتجه من المنطقة إلى الأسواق العالمية.-يعد مضيق باب المندب نقطة إستراتيجية تربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويعتبر من أهم الممرات البحرية في العالم.-يمتد المضيق على مسافة نحو 30 كيلومترا ويشكل معبرا حيويا للتجارة بين أوروبا وآسيا.-يعد هذا الممر مهما للتجارة العالمية، حيث يمر عبر المضيق نحو 10% من التجارة البحرية العالمية، بما في ذلك صادرات النفط من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية.-يمر عبره نحو 4.8 ملايين برميل من النفط يوميا.-يمر عبره سنويا نحو 10 آلاف سفينة، منها نحو 4 آلاف سفينة نفط.-المضيق يواجه تحديات أمنية كبيرة بسبب الصراعات في اليمن والصومال، وذلك مما يزيد من خطر تعطيل حركة السفن.-تربط قناة السويس المصرية بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتسهم بذلك في تسهيل التجارة بين آسيا وأوروبا.-يمر عبرها 12% من إجمالي حجم التجارة البحرية العالمية، ويعبرها سنويا ما يقرب من 20 ألف سفينة.-افتتحت عام 1869، وتمتد على مسافة 193 كيلومترا.-وصلت إيرادات القناة في العام المالي 2023-2024 إلى 7.2 مليارات دولار.-حسب وزارة التجارة الصينية، يمر نحو 60% من صادرات الصين إلى أوروبا عبر البحر الأحمر، ويرى مراقبون أن السيطرة على هذا الممر الإستراتيجي يجعل حتما تلك التجارة تحت مراقبة الولايات المتحدة.-واشنطن تسعى لإبلاغ رسالة للجميع أنها الفاعل الرئيس في المنطقة، على المستويين الأمني والإستراتيجي، خاصة بعد تواتر بعض الدعوات المطالبة بتغيير خارطة التحالفات من الغرب إلى الشرق وبصفة خاصة نحو الصين.-يقول خبراء إن تواصل سيطرة واشنطن وهيمنتها على الممرات الملاحية في الشرق الأوسط تعني أنها ما زالت تمسك بخيوط القيادة الدولية للعالم، كما أنها تتصدى بفاعلية للصين كونها لن تكون قادرة على حماية مشروعها "الحزام والطريق" وهو النهج التنموي الذي تتبناه بكين لإحياء طريق الحرير القديم.-تضييق مساحة العمل أمام القاعدة البحرية الصينية في جيبوتي، إذ تشكل إضافة مزيد من الأصول العسكرية للبحرية الأميركية والغربية بالقرب من القاعدة الصينية الوحيدة في المنطقة، ضغطا إضافيا لقدرات هذه القاعدة.

واشنطن- ردت الصين على رفع البيت الأبيض التعريفات الجمركية على منتجاتها بنسبة 104% برفع التعريفات الجمركية من جانبها إلى نسبة 84%، بدلا من 34% كما كان مقررا، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين بكين وواشنطن.وكانت الصين قد تجاهلت الموعد النهائي لإلغاء التعريفات الانتقامية الجمركية التي فرضتها عقب فرض الرئيس دونالد ترامب عليها تعريفات يوم الأربعاء الماضي قيمتها 34%، وعليه، قررت واشنطن رفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى 104%، قبل أن يعود ترامب اليوم الأربعاء ويرفعها إلى 125% تسري على الفور.وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بين أكبر دولتين اقتصاديتين في العالم، لتضاعف من المخاوف العالمية من نشوب حرب تجارية تضر بمختلف اقتصاديات العالم.وكانت أسواق المال العالمية قد شهدت منذ يوم الخميس الماضي تدهورا وعمليات بيع واسعة نتج عنها الكثير من الخسائر في أسواق المال العالمية تخطت قيمتها تريليونات الدولارات بسبب خطوة الرئيس ترامب التي يبدو أنه لا يزال متمسكا بها رغم تزايد الأصوات المعارضة لها داخل وخارج الولايات المتحدة.وحدد البيت الأبيض منتصف ليلة الثلاثاء 8 أبريل/نيسان توقيتا نهائيا، يبدأ بعده، ومع أول ساعات يوم الأربعاء 9 أبريل/نيسان، دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ على المنتجات الصينية. فاجأت الصين إدارة ترامب بتحديها قرار فرض التعريفات عليها، والتي ردت بالمثل وقررت في اليوم نفسه فرض 34% على المنتجات الأميركية، قبل أن تعود وترفعها إلى 84% ردا على الخطوات التصعيدية الأميركية.كذلك قيدت بكين عمل بعض الشركات الأميركية داخل الصين في الوقت ذاته، وحظرت تصدير العديد من المعادن النادرة للولايات المتحدة.ويهدف ترامب من رفعه التعريفات الانتقامية على الصين لبعث رسالة على ما يمكن أن تتوقعه الدول الأخرى التي تحذو حذوها.وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت -أمس الثلاثاء- إنه نظرا لرفض الصين رفع تعريفتها الانتقامية، فإن التعريفة الجمركية الإضافية البالغة 50% التي فرضها الرئيس بالإضافة إلى التعريفات الجمركية المفروضة سابقا بنسبة 20% و34% دخلت حيز التنفيذ، مما رفع إجمالي التعريفة الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.وذكرت ليفيت أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يجب أن يأتوا إلى الإدارة بصفقات وعروض لتحسين شروط التجارة، وأضافت "كانت رسالة الرئيس بسيطة ومتسقة منذ البداية إلى جميع دول العالم، ارجعوا لنا بأفضل عروضكم وسوف نبحثها، ولن يتم إبرام الصفقات إلا إذا كانت تفيد العمال الأميركيين وتعالج العجز التجاري الخانق لأمتنا".وذكرت أيضا "أن دولا مثل الصين، التي اختارت الانتقام، وتحاول مضاعفة إساءة معاملتها للعمال الأميركيين ترتكب خطأ".واعتبر المصرفي شريف عثمان، الخبير الاقتصادي بشركة "بويز للاستثمار" (Poise Investment) أن ترامب تعامل بطريقة مهينة مع الصين، وأن ترامب لا يزال يرى الصين كدولة نامية.وقال "إن منح ترامب الصين مهلة 24 ساعة قبل أن يفرض المزيد من التعريفات عليها اعتبرته بكين سلوكا مهينا وغير مقبول. وكان من الصعب على القيادة الصينية التراجع والخضوع لشروط ترامب في هذا الوقت الضيق".وركزت إدارة ترامب على إستراتيجيتها للتعريفة الجمركية حول القضاء على العجز التجاري، حيث احتسبت واشنطن صيغة لتلك التعريفات بناء على حجم العجز التجاري الأميركي مع مختلف الشركاء التجاريين.ويميل الاقتصاديون إلى رفض العجز التجاري باعتباره ليس جيدا ولا سيئا، بحجة أنه نتيجة لقرارات تجارية ذات منفعة متبادلة.وهناك العديد من الأسباب التي تجعل بعض البلدان لديها فوائض تجارية، والبعض الآخر يعاني من عجز. لا يوجد سبب متأصل لتكون هذه الأرقام متعادلة فبعض الدول أفضل من غيرها في صنع منتجات مختلفة، ولديها موارد طبيعية وبشرية مختلفة، وهذا هو أساس التجارة العالمية الحرة.كذلك يبدو أن ترامب يتجاهل حقيقة أن بلاده لديها فائض قدره 280 مليار دولار في مجال الخدمات المالية والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.وفي حديث تلفزيوني، قال رايان يونغ، كبير الاقتصاديين في معهد المشاريع التنافسية، "إن الموازين التجارية لا تقول أي شيء عن الصحة الاقتصادية للبلد، سواء كانت جيدة أو سيئة"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري لأكثر من 50 عاما.وتابع يونغ إن "الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري كل عام منذ السبعينيات، ومع ذلك فإن مستويات المعيشة أفضل بكل المقاييس تقريبا، سواء كان ذلك في الدخل، أو معدل البطالة، أو متوسط العمر المتوقع، أو النسبة المئوية للأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها مكيفات هواء أو إنترنت وسلع أخرى".من جانب آخر، وفي حديثه مع الجزيرة نت، أشار شريف عثمان إلى أن التصعيد والتصعيد المتبادل بين واشنطن وبكين يهدف إلى محاولة فرض قواعد جديدة قبل توجههما للتفاوض على ترتيبات تجارية جديدة.وأرجع عثمان سبب غضب ترامب الكبير من الصين إلى ما يعتبره "إجحافا للحقوق الأميركية، فالصين تدعم شركاتها، وتجنبها المنافسة الحرة مع مثيلاتها الغربية وخاصة الأميركية، كما أن الصين تلزم الشركات الأميركية بنقل التكنولوجيا إليها دون مقابل مناسب، في الوقت ذاته لا تتوقف الصين عن ممارسة سرقة الملكيات الفكرية".كذلك أشار الخبير المالي شريف عثمان، إلى أن فريق ترامب الاقتصادي يحاول جاهدا عرقلة صعود الصين اقتصاديا، وهي التي تعد قوة مرشحة لمناطحة الهيمنة الأميركية على النظام الاقتصادي العالمي، وتدرك واشنطن أن هيمنتها الأحادية على الاقتصاد العالمي في طريقها للتراجع".وذكر الخبير شريف عثمان أن الصين من جانبها "اعتمدت في تعاملاتها مع العديد من دول الجوار في القارة الآسيوية، وبعض دول الشرق الأوسط عملة اليوان الرقمية، وهذه في إطار جهد للابتعاد عن سيطرة الدولار الأميركي على التجارة العالمية.وقال: "بالفعل تبتعد الصين عن نظام السويفت الأميركي في تعاملاتها المالية، وتقلص من اعتمادها على الاستثمار في السندات الأميركية. كما أن بكين تستغل الانشقاقات التي يسببها ترامب مع حلفاء بلاده التقليديين، وعملت على إعادة صياغة علاقاتها التجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية".

أنقرة- يصل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى أنقرة غدا الخميس في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتعكس عمق الروابط التاريخية والتعاون المتنامي بين أكبر دولتين إسلاميتين من حيث عدد السكان، كما تأتي بعد أشهر من استقبال غير مسبوق حظي به أردوغان في جاكرتا خلال فبراير/شباط الماضي.ومن المقرر أن يلقي سوبيانتو خطابا أمام البرلمان التركي، ليصبح ثالث رئيس إندونيسي يقوم بهذه الخطوة. كما تأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخما متزايدا في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع.وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في منشور عبر "إكس" إن الزعيمين سيبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، بجانب قضايا إقليمية ودولية.تعود الجذور الرسمية للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإندونيسيا إلى عام 1950، حين كانت أنقرة من أوائل العواصم التي سارعت للاعتراف باستقلال إندونيسيا في 1949، مما أرسى أساسا مبكرا لتقارب سياسي وشعبي مستمر. وفي عام 1957، افتتحت تركيا سفارتها في جاكرتا، لتبدأ مرحلة من بناء صلات ثنائية أخذت تتعزز بمرور العقود، رغم المسافة الجغرافية بين البلدين.وشهدت العلاقات الثنائية محطة مفصلية في العصر الحديث بعد كارثة تسونامي المحيط الهندي عام 2004، حين قام رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، بزيارة إلى إقليم آتشه المنكوب في فبراير/شباط 2005، معبرا عن تضامن أنقرة مع الشعب الإندونيسي، في خطوة عززت الروابط الشعبية والرسمية بين البلدين.توالت بعد ذلك الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، وأسفرت في أبريل/نيسان 2011 عن إعلان مشترك بين الرئيس التركي عبد الله غُل ونظيره الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يوديونو، نص على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى "شراكة إستراتيجية" في إطار "عالم جديد"، مما مثّل تحولا نوعيا في مسار التعاون الثنائي.وتُوّج هذا المسار التصاعدي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين اتفق الجانبان على تأسيس "مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى" خلال قمة مجموعة العشرين في بالي. وقد عقد المجلس اجتماعه الأول في فبراير/شباط 2025 تزامنا مع زيارة أردوغان لإندونيسيا.وعلى الصعيد الدولي، ظل البلدان يحافظان على تعاون وثيق داخل المحافل المتعددة الأطراف، حيث يجمعهما عضوية فاعلة في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين، ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، فضلا عن شراكتهما ضمن منتدى "ميكتا".في السنوات الأخيرة، اكتسب التعاون بين تركيا وإندونيسيا زخما غير مسبوق، خصوصا في مجالي الدفاع والاقتصاد، حيث توجت الشراكة بتوقيع عشرات الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، مما جعل من أنقرة وجاكرتا نموذجا صاعدا لتحالف إسلامي إقليمي متقدم.وخلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جاكرتا في فبراير/شباط 2025، وقع الجانبان 13 اتفاقية تعاون في مجالات الصناعات العسكرية، أبرزها اتفاق لإنشاء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيرة داخل إندونيسيا.وينص الاتفاق، الذي أبرم بين شركة "بايكار" التركية و"ريببليكورب" الإندونيسية، على تصنيع 60 طائرة بدون طيار من طراز "بيرقدار تي بي 3″ و9 طائرات من طراز "أقنجي"، مع تصدير مباشر لهذه الطائرات إلى جاكرتا.واقتصاديا، تتقدم أنقرة وجاكرتا بخطى ثابتة نحو تعميق التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، فخلال عام 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 3.1 مليارات دولار، سجلت خلالها إندونيسيا فائضا تجاريا قُدر بـ1.47 مليار دولار، حسب بيانات هيئة الإحصاء التركية.وفي قمة القادة الأخيرة في 12 فبراير/شباط 2025، أعلن الرئيسان عزمهما رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2026، كهدف طموح تسنده خطة اقتصادية شاملة.ولتحقيق ذلك، اتفق الجانبان على تسريع المفاوضات بشأن توسيع اتفاقية التجارة التفضيلية الحالية، تمهيدا للوصول إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يتيح نفاذا أوسع للمنتجات التركية والإندونيسية إلى الأسواق بشكل متوازن.وفي هذا السياق، تم الاتفاق على إطلاق "منتدى البنية التحتية التركي- الإندونيسي" لدراسة فرص الاستثمار المشترك في مشاريع التنمية.ورحّبت جاكرتا بالمساهمة التركية في تنفيذ خطتها الوطنية للإسكان التي تستهدف بناء 3 ملايين وحدة سكنية، إلى جانب دعم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة "نوسانتارا" في جزيرة بورنيو.يرى الباحث في العلاقات الدولية مصطفى يتيم، أن إلقاء الرئيس الإندونيسي كلمة أمام البرلمان التركي يأتي في سياق الزخم الذي أحدثته جولة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى كل من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان في فبراير/شباط الماضي، والتي وصفها بأنها "أثمرت نتائج قوية وفعالة".وأشار يتيم في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما في العلاقات مع الدول الإسلامية في جنوب شرق آسيا، خاصة مع البلدان التي تتقاطع مع تركيا في الخلفيات الثقافية والهُوياتية.وأضاف أن زيارة سوبيانتو لأنقرة وإلقاءه كلمة تحت قبة البرلمان، بعد فترة وجيزة من زيارة أردوغان إلى جاكرتا، تعبّر عن مرحلة جديدة من التقارب، وتؤشر إلى أن هذه الدول بدأت في إعادة اكتشاف الروابط التاريخية المشتركة مع تركيا، وتعزيز التعاون معها في المجالات السياسية والاقتصادية.يرى المحلل السياسي علي فؤاد جوكشه، أن زيارة الرئيس الإندونيسي إلى تركيا تحظى بأهمية بالغة، ليس فقط من منظور العلاقات الثنائية، بل أيضا في ضوء التطورات الإقليمية والدولية.ويضيف جوكشه في حديث للجزيرة نت، أن إندونيسيا، باعتبارها دولة إسلامية كبرى غير عربية، تعد شريكا مهما في تشكيل موقف إسلامي موحد تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو ما يفسر مساعي أنقرة لتنسيق أكبر مع جاكرتا في هذا الملف.لكن الأهمية الأبعد للزيارة برأيه، تكمن في البُعد الجيو-اقتصادي المتعلق بالتحول العالمي من "جيوبوليتيكا الطاقة الهيدروكربونية" إلى "جيوبوليتيكا المعادن الحرجة"، التي باتت تمثل المحور الرئيسي للصراعات الاقتصادية الكبرى. ويوضح أن إندونيسيا تمتلك نحو 38% من احتياطات "النيكل" العالمية، وهو أحد أهم المعادن الإستراتيجية المطلوبة في صناعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.ويلفت إلى أن تركيا تسعى إلى تأمين جزء من احتياجاتها التكنولوجية من المعادن الحرجة عبر تعزيز شراكاتها مع دول مثل إندونيسيا، وذلك بالتوازي مع رغبتها في ترسيخ حضورها السياسي والاقتصادي في جنوب شرق آسيا، والحصول على دعم دولي أوسع في ملفات العالم الإسلامي.أوضح الباحث التركي مصطفى يتيم أن تركيا، في إطار مبادرتها "آسيا من جديد"، تسعى إلى تعزيز انخراطها في القارة الآسيوية عبر بناء شراكات متينة مع دول رئيسية مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين، وهي دول تتمتع بثقل سكاني واقتصادي، وتربطها بتركيا قواسم ثقافية وإسلامية.وبيّن أن هذه المبادرة لا تقتصر على الشراكات الاقتصادية فقط، بل تنطلق من أولوية تعزيز الحضور السياسي أولا، ثم تعميق العلاقات الاقتصادية لاحقا، في إطار إستراتيجية طويلة الأمد.وأشار إلى أن تركيا تنظر إلى إندونيسيا كواحدة من الدول المركزية في هذه المبادرة، معتمدة على أرضية من التعاون التاريخي والمواقف المشتركة المناهضة للاستعمار، كونها ستؤدي دورا أكثر مركزية في المرحلة المقبلة ضمن سياسة الانفتاح التركي على آسيا.